إقبال نامه
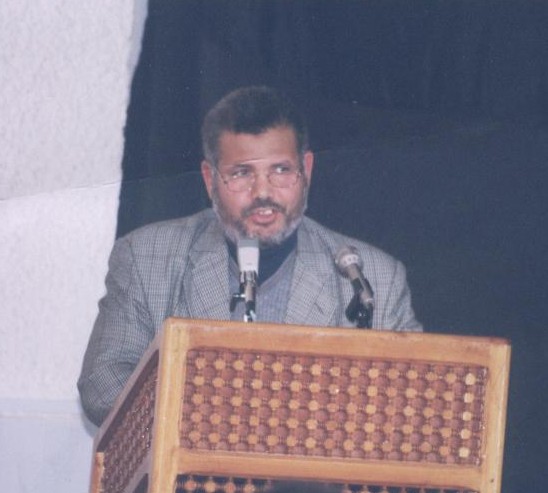
د.حسن الأمراني
هَلْ تَعُودُ لَيْتَ شِعْرِي النغمة التي أرسلها الفضاء؟
وهل تعود النفحة الحجازية؟
ها قد أظلني الموت..وحضرتني الوفاة
فليت شعري هل حكيمٌ يخلفني؟
محمد إقبال، قبيل وفاته
أنا وإقبال والشعر
هذا شاعر أحببته.
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لتمنيت أن أتعلم الأوردية والفارسية لأمر واحد، وهو أن أقرأ محمد إقبال في أصوله.
إنه شاعر الإنسان في كل زمان ومكان.
لعله أول شاعر عرفته خارج دائرة العربية. عرفته في شبابي من خلال بعض ترجمات عبد الرحمن عزام والصاوي شعلان وعبد المعين الملوحي.ثم عرفته من خلال (روائع إقبال)، وهو الكتاب الرائع الذي قدمه للعربية العلامة أبو الحسن الندوي، وعرفته من خلال ما كتبه عنه صديقي الأثير وأستاذي في ميدان الأدب الإسلامي الأديب المرحوم الدكتور نجيب الكيلاني، الذي كان يكنّ لإقبال، فيما أحسب، مثل ما أكنّ له.وكتابه: (محمد إقبال الشاعر الثائر) ببعض ذلك ناطق.
وفي الجامعة عرفته مفكرا وفيلسوفا. قربنا منه أكثر أستاذنا الدكتور محمد الكتاني، وعرّفنا إلى كتاب إقبال الفلسفي: (تجديد الفكر الديني في الإسلام)، هذا الكتاب الذي كان وما يزال من الكتب القلائل التي أرجع إليها كثيرا.
شاعر أحببته، وكل حين كان يحدث ما يحببه إلي أكثر.
وعندما زرت الهند، لأول مرة، منذ عشرين سنة، كان في ذهني الظفر بثلاثة أشياء:زيارة ندوة العلماء، وزيارة تاج محل في أكره، واقتناء ديوان إقبال. وحصلت على هذه الثلاثة:أما ندوة العلماء فكانت هي التي استضافتنا، في المؤتمر التأسيسي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية، وأما تاج محل فقد انتقلت من دلهي إلى اكره لزيارته، وكان لي فيه قصة.. وأما ديوان محمد إقبال فقد كنت أطوف في المكتبات في دلهي فعثرت على ديوانه الذي يجمع أشعاره الأوردية دون الفارسية معروضا على الناس بشكل لافت ..فاقتنيته. وهو إلى الآن في مكتبتي أعود إليه بين الحين والحين للمقارنة. اقتنيته بالرغم من أني لا أعرف الأوردية، كما اقتنيت أشعار نجيب فاضل بصوته وأنا لا أعرف التركية.
وكان ممن عقد الصلة وثيقة بيني وبين إقبال هو العلامة الشيخ أبو الحسن الندوي.إنه أديب ذواقة. كنا مرة في إستانبول فقام شاعر هندي ، واسمه، طفيل مدني، ينشدنا من شعره هو. والهنود إذا أنشدوا أطربوك، لأنهم فعلا ينشدون الشعر ولا يقرؤونه..في مقطع من المقاطع اهتز الشيخ أبو الحسن، وطرب طربا شديدا فقلنا:لابد أن تترجموا لنا هذا المقطع الذي أطرب الشيخ كل هذا الطرب، قالوا: إن الشاعر يقول في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم:
أيها الموت المفاجئ
أمهلني قليلا
أما تراني مشغولا بمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
والشيء بالشيء يذكر..في المؤتمر التأسيسي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية، في ندوة العلماء، في إحدى الجلسات الشعرية التي قرأ فيها الشعراء العرب والهنود، وكان عريف الحفل الأستاذ محمد حسن بريغش رحمه الله تعالى، طلب من أحد أطفال الندوة أن ينشد شيئا من شعر إقبال، فقام طفل، واسمه محمد إسماعيل، وهو اليوم من الأساتذة المعروفين، وأنشد بصوت شجي مؤثر قصيدة إقبال: (دعاء طارق)، كنت أنا من أشد الناس طربا، وأنا أسمع اسم طارق يتردد في شعر لم أفهم معانيه. ألم أقبل على إقبال من أرض طارق بن زياد؟ وعجبت كيف يحفظ أطفال الهند شعر الشاعر الكبير إقبال ويتذوقونه، وكبار شعراء الحداثة عندنا في العالم العربي، لا يكاد يفهم بعضهم بعضا، فضلا عن أن يحفظه جماهير الناس، هذا وكثير منهم يزعم لنفسه الالتزام بقضايا الناس.
وأبو الحسن رحمه الله لا يترك مناسبة تمر دون أن يشيد بإقبال أو ينشد بعضا من شعره.هو عنده الشاعر الإنساني الأول.
وعندما كنت بأوربا، عامي بين أكتوبر 1984 أكتوبر 1986، كان محمد إقبال حاضرا..عدد من المعاهد الغربية كانت تدرس فلسفة إقبال وشعره.وفي الغرب عنيت عناية خاصة بالشعراء الذي كانت لهم صلة بالشرق، ولا سيما بالشرق الإسلامي.وهناك تعرفت أكثر على شعر الشاعر الألماني غوته، من خلال ديوانه:
) WEST OSTLICHER DIWAN (
أي، الديوان الشرقي الغربي، أو (الديوان الشرقي للشاعر الغربي) كما آثر أن يترجمه المرحوم عبد الرحمن بدوي،إلى إشارة من الشاعر نفسه وردت في بعض النسخ القديمة. وعرفت العلاقة بين الشاعرين الكبيرين . كان غوته شاعرا مغرما بالشرق، وبالشرق الإسلامي بخاصة،كان مغرما بالقرآن الكريم،وبشعراء الشرق، وشعراء الفرس منهم على وجه الخصوص.ولكنه بقي غربيا في روحه. واطلع محمد إقبال على غوته في لغته، يوم كان في ألمانيا يحضر شهادة الدكتوراه، وألهمه ذلك ديوانه: (بيام مشرق)، أي رسالة المشرق، يحاور فيها الشاعر الغربي غوته. وقد اجتمع في نفسي حب هذين الشاعرين:هذا شاعر المشرق، وشاعر الإسلام، وذلك أعظم شاعر غربي تغنى بالمشرق.
ولكن منزلة إقبال في نفسي بقيت دائما منزلة خاصة.يسكنني ويوجه سفينتي الشعرية، وأحلم بكتابة ملحمة شعرية عنه، أو باستيحاء منه، وكما قال فكتور هيغو يوما: (أريد أن أكون شاتوبريان أو لا أكون)، كنت أقول: (أريد أن أكون محمد إقبال أو لا أكون).
فلما أعلنت رابطة الأدب الإسلامي العالمية، ومكتبها في باكستان، عن الاحتفاء بمحمد إقبال، في لاهور، حيث مزاره، وفي إيوان يسمى: (إيوان إقبال)، وكنت من المدعوين إلى هذا اللقاء، انطلقت الأشواق المحبوسة من عصور في قلبي، فكانت هذه الملحمة.
هذا الملحمة تنتمي إلى دائرة الشعر، ومن هنا فهي من فيض الوجدان، وهي تبعا لذلك مستجيبة للخطاب الشعري الرامي إلى التعجيب، وهي تعتمد التخييل، ولكنه التخييل المنضبط بقواعد الفن.إنه ما جعل أرسطو يحكم على الشعر بأنه أكثر صدقا من الفلسفة ومن التاريخ، لأن هذين يعنيان بما هو جزئي، وأما الشعر فيعنى بما هو كلي.هما يعنيان بالنسبي، وهو يعنى بالمطلق. ومن هنا فإننا على مذهب الأسلاف في هذا، إذ يقول ابن سلاّم: (والشاعر يظنّ فلا يحقق). فليس لك أن تحقق مع الشعر وتحاكمه بقواعد التاريخ.
على أننا لسنا من الأسطورة في شيء.إن الحقائق الشعرية أبلغ من الأساطير وأوهامها. وإن حديث القلب وفيض الوجدان أعمق من أغوار المحيط. ولذلك لم يكن التاريخ غير إضاءات مما ترسب في الأعماق، لم أرجع فيها إلى مصادر التاريخ، ولا إلى كتابات المؤرخين.ودفقة الشعر لا تقبل كل ذلك، لأنك إن وقفت تتأملها ضاعت منك لحظة الإبداع، كالراقص الذي لا يستطيع أن يتأمل رقصته ساعة الأداء، وإلا ارتبك وتوقف وضاعت منه لحظته الفنية. وهل أحتاج وأنا أتحدث عن طارق بن زياد الذي يسكنني، وعن الأدارسة والمرابطين الذين يستوطنون دمي، وعن عظماء الإسلام من الفاتحين والشعراء والمتصوفة والمصلحين من القدماء والمحدثين إلى شيء من المصادر، غير أن يكون المصدر الذاتي الذي ترسب من سنوات التكوين، واختلطت خيوطه بخيوط المصدر الشعري؟
على أني أستثني من ذلك كله النشيد الذي يتحدث عن فاتح الهند، محمد بن القاسم الثقفي، فقد كانت وفرة الأحداث التاريخية وجوهرية الحدث في الملحمة تفرض أن أكون أكثر التصاقا بالتاريخ، وأن أكون أكثر إخلاصا واستجابة للتجربة الشعورية الممتزجة مع الفكر.هنا يمتزج الوجدان بالفكر، وتختلط الرؤى التأملية بسيرورة التاريخ وصيرورته. هنا كان لا بدّ من الاستعانة بما دوّنه المؤرخون، وسطرته أنامل الفن، وريشة الإبداع. ولكنني لم أنس أنني أنجز عملا شعريا، لا تاريخيا.فلذلك كان لا بد لجمرة الإبداع من أن تظل متقدة، لا تطفئها صرامة السرد التاريخي وواقعيته. ولا يعني هذا تزييف الأحداث أبدا ولا تشويهها، بقدر ما يعني تلوينها بما يناسب الخيال الشعري، وينسجم مع ظلال الفنّ وإيحاءاته،ولا يجاوز الحق في الوقت ذاته ولا يصادم منطق التاريخ. ولئن كنت قد استشرت بعض كتب التاريخ،مثل تاريخ الطبري، إلا أن لكتاب الأستاذ محمد عبد الغني حسن عن (بطل السند) فضلا كبيرا على بناء هذا النشيد، ذلك بأنه كتاب يجمع بين وقائع التاريخ ونداوة الفن، وفيه من التفاصيل ما ليس في سواه، ممّا هو مناسب جدا للبناء الملحمي. فهل جار التاريخ على الفن في هذا النشيد، أم أن التاريخ كان ممدا للشعر في التحليق بأجنحة جديدة؟
لقد أصدرت خلال ما يزيد عن ثلاثين سنة خمسة عشر ديوانا، ونشرت مثل ذلك من القصائد، مما لم يجمع بعد في ديوان، وتحت يدي من الشعر مما لم ينشر ولم يطلع عليه أحد شيء كثير. ولكنني أظن أنني بهذه الملحمة قد حققت بعضا مما كنت أحلم به، كما لم يتحقق في غير ذلك من أشعاري..
بنيتها على وزن واحد وقافية واحدة،على أن حركة الروي في نشيد (إيوان إقبال)، وهو أول نشيد انطلقت منه الكتابة، جاء مضموما، على غير ما هي عليه بقية الأناشيد التي جاء رويها مكسوراً.كان ذلك على غير قصد مني، وكان الكسر هو الموافق لأسماء بعض الأعلام وأنسابهم.
هنالك أمر آخر أشير إليه، وهو يتعلق بضمير المتكلم في القصيدة: (الأنا). هل هي أنا الشاعر؟ أذكر هذا لأن أديبا فاضلا قال لي وقد أطلعته على القصيدة إن بعض الأبيات غامضة، لأن الضمير فيها مبهم مرجعه، أهو يعود على إقبال أم عليك؟
من البيّن أن الشاعر القديم كان لا يستعمل ضمير المتكلم في الغالب إلا للدلالة على أناه هو، أي على نفسه، والشعر القديم أكثره ذاتي، وذلك ميسم له، وقد شذت عن تلك القاعدة بعض النصوص المعدودة، ولاسيما في العصور المتأخرة نسبيا.
أما في العصر الحديث، ومع حركة الشعر المعاصر بخاصة، فقد ظهرت تقنيات جديدة، ومنها تقنية القناع التي جعلت ليس من اللازم أن يكون ضمير المتكلم يدلّ على الشاعر، وإلا أدى ذلك إلى نوع من الإحالة، حيث لا يستقيم أن يعني الشاعر نفسه وهو يقول مثلا، كما قال السياب في قصيدته: (المخبر).
أنا ما تشاء، أنا الحقير
صبّاغ أحذية الغزاة، وبائع الدم والضمير
للظالمين، أنا الغراب
يقتات من جثثت الفراخ، أنا الدّمار،أنا الخراب
إلى آخر ما قال. فالعاقل لا يفوته أن يدرك ببصيرته المراد. وقد سعى إحسان عباس رحمه الله، في دراسته عن السياب، إلى أن يحدد بالتدقيق، وبالاسم، من كان يعني الشاعر في قصيدته.
ومن أشهر من حاد عن سلوك النمط المألوف، وإن بأسلوب أقل تعقيداً وأكثر بساطة، نزار قباني رحمه الله. فقد كتب معظم قصائده على لسان المرأة، حتى قال العقاد عنه، معجبا بشدة غوصه في دقائق المرأة الداخلية: (هذا الشاعر امرأة).
فقد صار واضحا أن القصيدة المعاصرة تجاوزت حصر (الأنا) في الشاعر.
فمن المتكلم في القصيدة التي بين يديك أيها القارئ الكريم؟
إنه أكثر من صوت، أو إنه بالتحديد ثلاثة أصوات متميز بعضها عن بعض، وإن بدت في بعض الأحيان متداخلة، قد تثير بعض الغموض الذي أشار إليه صديقي الشاعر الداعية. وهذه الأصوات هي: صوت المسلم الكامل صوت إقبال صوت الشاعر. وهي بحسب الألفاظ القرآنية: النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء.
فضمير المتكلم ينصرف أحيانا إلى المسلم الكامل، والمسلم الكامل يتجلى بخاصة في الأنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم في القصيدة، وأعلاهم منزلة محمد صلى الله عليه وسلم، كما يتجلى في الإنسان المستقبلي الذي يحلم به الشعراء والمصلحون، كما حلم به إقبال وكما أحلم به دائما.وربما في هذا الإطار بدت بعض الصيغ متجاوزة حدودها في جنوحها إلى هذا الامتزاج الذي هو أكثر من قناع. وكنت قلت في نشيد من القصيدة:
إني أنا موسى سأبطل سحره والطور منتظر لشحذ بياني
فكتب إلي أديب حبيب، وناقد أريب :
(وفي رسالتك إلى القارئ أوقفني بيتك الأخير ببلاغته وجرأته معا وسمحت لنفسي
أن أقرأه بطريقة مختلفة تحرّجاً، ولا أدري إن كنت توافقني على قراءتي رغم اعترافي
بتفوق قراءتك بيانيا على قراءتي ولكنه التأثّم كما قلت من أن تكون في مكان موسى
عليه السلام:
إني عصا موسى سأبطل سحره والطور منتظر لشحذ بياني).
وقد أخذت بهذا التعديل لوجاهته وقوته، ولكونه لا يتناقض مع التوجه العام للقصيدة، إن لم يكن أكثر انسجاما من الصيغة الأولى.
إن (الأنا) في القصيدة، إن كانت دالة على النفس المطمئنة القوية، فهي تصوير للإنسان الكامل الذي أشرت إليه بصورته التاريخية والمستقبلية، ويستحيل أن يكون الضمير في ذلك متعلقا بالشاعر المقر بضعفه الإنساني وعجزه الكبير.
والصورة الثانية هي أن تأتي (الأنا) دالة على (النفس اللوامة) الطامحة، وفي هذه الحالة فهي في معظم الأحيان تشير إلى محمد إقبال، وربما وقع نوع من التقاطع بين النفس المطمئنة والنفس اللوامة عند الحديث عن إقبال، إذ هو في بعض الأحيان يحلق بعيدا.وربّما جاء ذلك إشارة إلى الشاعر المسلم، كما ينبغي أن يكون، مثل هذين البيتين:
ساقوا أساطير الحديثِ وزخرفوا من قولهم ما حيل في الأذهانِ
وأتيتُ بالحقّ المبين مصلصلاً كالسيف منهُ يفرق الضدّانِ
وستجد في القصيدة مثلا قول الشاعر: (أنا طارق)،أعني طارق بن زياد، فاتح الأندلس، و(أنا الباهلي)، أي قتيبة بن مسلم،فاتح خراسان وتركستان، وقد يكون ضمير المتكلم المفرد دالا على الجماعة، مثل قوله: (وأنا رياض الصالحين)، إشارة إلى شهيدات مسرح موسكو.هذا فضلا عن قوله: (إني أنا موسى)، أو (إني عصا موسى) فهل يسبق إلى الذهن أن الشاعر يعني نفسه بحال من الأحوال؟ كلا.
وأما الصورة الثالثة، وهي النفس الأمارة، فهي في معظم الأحيان نفس الشاعر المنكسرة، وإن كان لا يمتنع في هذه المرحلة بروز الأنا اللوامة، باعتبارها طموحا، وقلما برزت في هذا القسم صورة الأنا المطمئنة، إلا أن يكون ذلك وجها من أوجه الطمع في الدخول من باب الرحمة الإلهية.
على أنّ هذا الأسلوب الذي قد يشم منه بعض الغموض لم يغب عن شعر إقبال.فكثرا ما كنت الضمائر عنده تتداخل. إنه أحيانا يستعمل ضمير المتكلم وهو يعني المسلم عموما. والمسلم عنده هو الإنسان الكامل،والمسلم حي خالد، والمسلم كالشمس، لا تغرب مطلقا. (راجع روائع إقبال لأبي الحسن الندوي). وبسب هذا التداخل في الضمائر أدركت الحيرة مترجمي شعره أحياناً، لا في ضمير المتكلم فحسب، بل حتى في الضمائر الأخرى، من المخاطب والغائب، مما يفتح باب التأويل واسعاً.ففي ديوان جناح جبريل، من قصيدة في أرض فلسطين، جاءت هذه الأبيات:
فسل حنيناً وبدراً عن حروبهما كم ضرّج الحبّ فيها من فؤاد كمي
في آية الخلق أنت السرّ لا أحدٌ ولو تجلّيت ما أبقيت من عصم
لأجل معناك ما تلقى وما لقيتْ قوافل القومِ في الوديان والأكمِ
وقد علق مترجم/مترجمو الديوان، أو معده بالقول: (يبدو أنّ إقبالا في المقاطع الثلاثة اللاحقة يخاطب الله عز وجلّ، ومع ذلك فإنّ التأويل غير مؤكد.)
فعسى أن يكون في هذه الإشارة ما يقي القارئ من اللبس والإبهام الذي قد تتعرض له القصيدة.
أما ما سوى ذلك من اللمح والإشارة وما يفتحه التخييل الفني من أبواب التأويل فذلك ما لا مندوحة عنه في كل عمل فني، والشعر في ذلك أحق من غيره من ألوان الفن وأولى.
ستستوقفك في القصيدة، أيها القارئ، إشارات تاريخية وغير تاريخية، تركت أكثرها دون شرح وتبيين اعتماداً على فطنتك، وإشفاقاً عليك من كثرة الهوامش، إلا قليلا، مما قد يصعب الوصول إليه.
وسلام عليك، أيها القارئ.
مدخل
| فـجّـر عيون الشعْر يا أمراني (ثـكـلـتك أمّك يا معاذُ) محجّةٌ واعطفْ ركابك نحو وادي عبقرٍ واذرفْ دمـاءَ القلبِ، آيةَ عاشقٍ شـاهـنـامة اسفنديار أو إنيادة | وتـحـرّ مـمّـا يكْتُبُ الملَكانِ لـك، فـاتّخِذْ منها جنَاك الداني واصرفْ هواك إلى خطى حسّانِ تـمـنـحْـك صيّبها يَدُ التبيانِ الـرومـان أو إلـيـاذة اليونانِ |
(واضح أن الشاهنامه هي للفردوسي، من شعراء الفرس في القرن الرابع الهجري، إلا أنني نسبتها لإسفنديار، لكثرة تمجيد الشاعر لأساطير الأكاسرة من إسفنديار وغيره من ملوك العجم.)
| سـاقـوا أساطير الحديثِ وزخرفوا وأتـيـتُ بـالحقّ المبين مصلصلاً إن الـحـقـيـقـة والجمال كليهما شُـرّدتُ في طول البلاد وعرضِها أنـا ما أرحْتُ على الطريق حقائبي قـلـبـي أنـا طـلـلٌ تقادم عهدهُ لـكـنّ نـفـخةَ خالقي من روحهِ فـابسطْ جناحَ الشّوق يُبْلغْكَ الحمى إنـي أنـا الـمـوعودُ بالفتحِ الذي أنـا طـارقٌ شـاقـته أزهَارُ الربا والـبـاهليّ أنا، بمصْباحي اهتدتْ وأنـا رياض الصالحين (*)تكشّفتْ أنـا صـيحة الحق الذي لا يُمترى وأنـا سـلـيـل الـحيْدريّ ونورُه ما أشتكي من غربتي؟ أنا غربتي ال رمـت الـحوادثُ مروتي فتقصّدتْ تـرتـدّ رايـاتُ الـمغولِ حسيرةً هـذا أنـا.. تدَعُ الحوادثُ صفحتي | مـن قـولـهم ما حيل في الأذهانِ كـالـسـيـف منهُ يفرق الضدّانِ لـلـفـنّ صـرحٌ حـين يجتمعانِ مـثْـل الـقطاةِ وما برحتُ مكاني فـكـأنـنـي بـيْـتٌ بلا عنوانِ كـم كـان بـعض مسارح الغزلانِ فـي الـطـينِ شدّت للسماء عناني فـالـرّوحُ لا تـحـيى بلا خفقانِ مـن نـوره قـدْ أشـرق الـملوانِ فـرويـت غـلّـتـها بدمّي القاني فـرقٌ لـدى الـمـهراج والخاقانِ عـنـه الـنـسـاء بهمّة الفرسانِ لـم تَـثْـن عـزميَ قبضةُ السجّانِ وأنـا وريـث رسـالـة (الأفغاني) زهـراءُ مـن حججي ومن برهاني مِـنْ دونـهـا كـتـقـصّد المُرّانِ كـلـمـى، وتُكْسَرُ شوكةُ الصُّلبانِ مـجـلـوّةً وتـزيـد فـي لمعاني |
![]()
![]()
![]()