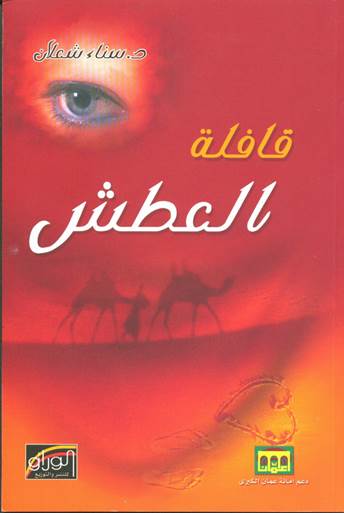الشاعر الإسلامي عبد الله عيسى السلامة: حياته وشعره

هو الشاعر الإسلامي الكبير عبد الله بيك الشيخ عيسى السلامة القاصّ ، والمفكر المعروف الذي أصدر خمس دواوين شعرية، وخمس روايات، ومجموعة من القصص القصيرة ، والبحوث والمقالات.. كما حصل على مراكز متقدمة من مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين، وتجمع شعراء بلا حدود، وحصد جائزة شاعر عكاظ عام 1430هـ/2009م..
يعد شعره في مستوى فني راق ، فهو جزل الأسلوب، متين العبارات، فصيح الألفاظ ، واسع الخيال، جمله متماسكة يشدّ بعضها بعضاً، ويأخذ بعضها برقاب بعض ...
المولد والنشأة :
والشاعر الإسلامي أبو ياسر (عبد الله عيسى السلامة ) من مواليد عام 1944م في قرية الحديدي، التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى رجل سكنها، ودفن فيها، من قبيلة (الحديدين) المشهورة، وكانت تسمى قبل ذلك (الناعورة)، يزيدُ عددُ سكانها على ألفي نسمة، تعتمد على زراعة القطن والحبوب وزراعة الأشجار المثمرة والزيتون، وهذه القرية تابعة لناحية (الخفسة) القريبة من مطار (الجراح ) العسكري، والتي تبعد حوالي / 100/ كم شرقي حلب، و30كم عن مدينة منبج ، وكانتْ من أوائل البلدان التي ثارت على طاغية الشام، وتتابعَ على السيطرة عليها الجيش الحرّ، ثم تنظيم الدولة الإسلامية، ثم عاد إليها النظام، بعد أن دمرها بالطيران والصواريخ، وهجر أكثر من ألف أسرة، وتتبع إدارياً لمنطقة (منبج) مدينة الشعر والشعراء التي أهدت إلى العالم : الشاعر الكبير (البحتري)، ودوقلة المنبجي، وعمر أبو ريشة، ومحمد منلا غزيل، ويوسف عبيد المحيميد، وعبد الله عيسى السلامة ..وغيرهم كثير، وتقع منبج في الريف الشرقي لمحافظة حلب في سورية .
ونشأ شاعرنا الحبيب في أسرة ريفية مسلمة محافظة، تنتمي إلى قبيلة (الولدة) إحدى فروع (البوشعبان)، والتي ترجع إلى قبيلة (زبيد) في اليمن، فوالده (الحاج عيسى ) كان ممن تعلم القراءة والكتابة في كتاتيب القرية، وكان مختاراً في قرية الحديدي في الستينات قبل استلام البعث مقاليد السلطة في سورية، ينظم الشعر النبطي، فتوجه ذلك الوالد للعمل في الأرض الزراعية التي ورثها عن أبيه، وتوفي في أواسط التسعينات من القرن العشرين - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - .
وأما الوالدة ( دلّة ) فهي ربة منزل، أمية لا تعرف القراءة والكتابة، حفظت الفاتحة وبعض السور القصيرة لقراءتها في صلاتها، تنتمي إلى قبيلة (الناصر) إحدى فروع (البوشعبان) ، وقد توفيت الوالدة الفاضلة – رحمها الله – في عام 2004م .
وعاش الشاعر بين إخوته الذين بلغ عددهم سبعة ذكور، وهم :
-عبد اللطيف، ومحمد (توفي) ، والمحامي عبد الإله الذي ينظم الشعر، وسعد الله، والمهندس عبد السلام الذي يحمل أربع شهادات ماجستير من جامعات ماليزيا، وحميدي .وترتيب الشاعر هو الثالث بينهم .
وله ثلاث أخوات تعلمن القراءة والكتابة على يد الشيخ المعلم الفلسطيني ( عبد الغني سليم).
دراسته ومراحل تعليمه :
درس عبد الله عيسى السلامة مبادئ القراءة والحساب وتلاوة القرآن على يد المعلم الفلسطيني ( عبد الغني سليم ) في قرية الحديدي .
ثم درس المرحلة الابتدائية في قريته، وحصل على شهادتها، وكانت تمنح في الصف الخامس عام 1955م ..وكان يدرسه في تلك الفترة المبكرة من العمر معلم فلسطيني ( عبد الغني سليم ) هاجر بعد الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين عام 1948م .
-ثم درس المرحلة الإعدادية حيث دخل في الصف السادس ( الأول الإعدادي ) في مدينة منبج عام 1956م .
-ثم أكمل دراسة الصف السابع والثامن والتاسع في إعدادية (سيف الدولة ) بحلب في الأعوام 1957- 1959م .. وكان يدرسه في تلك المرحلة الأستاذ محمد علي الهاشمي رحمه الله قبل أن يحصل على الدكتوراه، وينتقل إلى التدريس الجامعي .
وكذلك تلقى العلم على يد الأستاذ محمود فاخوري الذي انتقل بعد ذلك للتدريس في جامعة حلب .
ولا ينسى الشاعر فضل أحد أساتذته في تلك الفترة ألا وهو محمد سعاد السمان رحمه الله .
وبعدها انتقل إلى ثانوية (هنانو)، فدرس الصف العاشر في العام الدراسي 1960- 1961م.
ثم درس الصف الحادي عشر في ثانوية (الرائد العربي) في حلب عام 1961- 1962م .
وحصل على الشهادة الثانوية (الفرع الأدبي ) من ( المعهد العربي الإسلامي ) في حلب عام 1962- 1963م.
ومن أبرز أساتذته في المرحلة الثانوية هو الأستاذ الدكتور محمد فاروق بطل -حفظه الله- .
وكان مستواه العلمي جيداً في كافة مراحل الدراسة، ولا سيما في مادة اللغة العربية التي عشقها، وأحبها، وأبدع فيها، وكان من زملاء دراسته في المرحلة الإعدادية والثانوية: يمان عمر الأميري، والمدرّس محمد عطا جذبة، والمنشد المتألق (محمد أمين الترمذي) .
- ثم انتقل عام 1964م إلى دمشق لإكمال دراسته، وقد حصل في السنة الأول على درجة جيد جداً، فنالَ منحة مالية جيدة، وتابع تفوقه حتى حصل على شهادة الليسانس في الآداب، قسم اللغة العربية، من جامعة دمشق عام 1968م.
ونهل العلم على أيدي أساتذتها، وكان من أبرزهم :
1-الأستاذ سعيد الأفغاني (1909- 1997م) : نحوي بحاثة، ولد في دمشق، من عائلة ترجع في أصولها إلى مدينة (كونر) في أفغانستان، درس عليه عبد الله عيسى السلامة ( النحو والصرف) .
2-الأستاذ أحمد راتب النفاخ ( 1927- 1992م): عالم في الفقه والقراءات والتفسير والحديث واللغة والنحو والصرف والشعر وغير ذلك من علوم الدين والعربية ، ولد في حي الصالحية في دمشق ، وأسرته معروفة بسمو الأخلاق ورفعتها، وقد درس عبد الله السلامة عليه (الأدب الجاهلي) .
3-الدكتور شكري عمر فيصل ( 1918- 1985م ): ولد في حي العقيبة في دمشق لأسرة فقيرة، جاء أبوه من حمص إلى دمشق قبل الحرب العالمية الأولى ، حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة فؤاد الأول ( القاهرة الآن) درس السلامة عليه (النقد الأدبي) .
4-الدكتور عبد الكريم الأشتر ( 1927- 2011م ) : ولد في حلب ، وحصل على ليسانس في اللغة العربية من جامعة دمشق عام 1952م ، عين مدرساً في ثانويات حلب عام 1954م لمدة أربع سنوات، ثم حصل على الدكتوراه وانتقل إلى التدريس الجامعي ، وتوفي صباح الجمعة في 7 / 10 / 2011م ، وقد درس الشاعر عليه مادة (الأدب الحديث) .
5-الدكتور إحسان النص (1921- 2012م ) : من مواليد دمشق، درس الأدب العربي في مصر ، وعاد مدرساً في ثانوياتها ثم في الجامعة السورية ، درس عليه الشاعر ( الأدب الأموي) .
6-الدكتور مازن المبارك ( 1930- معاصر ) : من أسرة علمية مباركة، هاجرت من الجزائر مع الأمير عبد القادر الجزائري وسكنت دمشق ، عمل في التدريس في كلية الآداب ، ثم شغل منصب رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق ، تلقى الشاعر على يديه (فقه اللغة ).
7-الدكتور محمد أديب الصالح ( 1926- 2017م ): رئيس قسم القرآن والسنة في جامعة دمشق، وأستاذ أصول الفقه بكلية الحقوق فيها، ورئيس قسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ورئيس تحرير مجلة حضارة الإسلام، وقد درس عليه الشاعر عبد الله عيسى السلامة علوم الحديث.
8-الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ( 1929- 2013م ): ولد في جيلكا ، هاجر بصحبة والده إلى دمشق، درس في كلية الشريعة في جامعة دمشق، ثم أكمل دراساته العليا في الأزهر، عمل في التدريس، وصار رئيساً لقسم العقائد والأديان اغتيل عام 2013م، وقد درس الشاعر عليه علوم القرآن .
وكان من زملائه المقربين في الجامعة: عبد المجيد القادري، والدكتور صلاح كزارة ..وغيرهما.
وبعدها توجه عام 1984م إلى لبنان من أجل الدراسة، فحصل على شهادة ليسانس في الحقوق من جامعة بيروت العربية عام 1987م...ولم يكن يداوم فيها، بل كان يقدم الامتحانات في الجامعة الأردنية في عمان ..
أعماله والوظائف التي تقلدها :
وبعد تأدية خدمة العلم برتبة ملازم مجند بين عامي ( 1969- 1972م ) عمل مدرساً في ثانويات مدينة حلب وريفها .
ثم غادر سورية في أحداث الثمانينات من القرن الماضي، فعمل مدرساً في كلية المجتمع الإسلامي في الزرقاء، الأردن بين عامي / 1983- 1987م / .
دخوله السجن :
دخل الشاعر (عبد الله عيسى السلامة) في سجن الحلبوني بدمشق عام 1973م، لأسباب سياسية ، وعندما كان في المعتقل ترامى إلى سمعه نبأ وفاة الأستاذ المرشد (حسن الهضيبي) – رحمه الله -، فرثاه بقصيدة تحت عنوان: ( مشعل عزة)، ومطلعها :
(أتينا إلى الدنيا، فكنّا لها فجرا فقرّت بنا عيناً ، وطابت بنا ذكرا )
[1] - ثآليل في جبهة السامري : ص 23 .