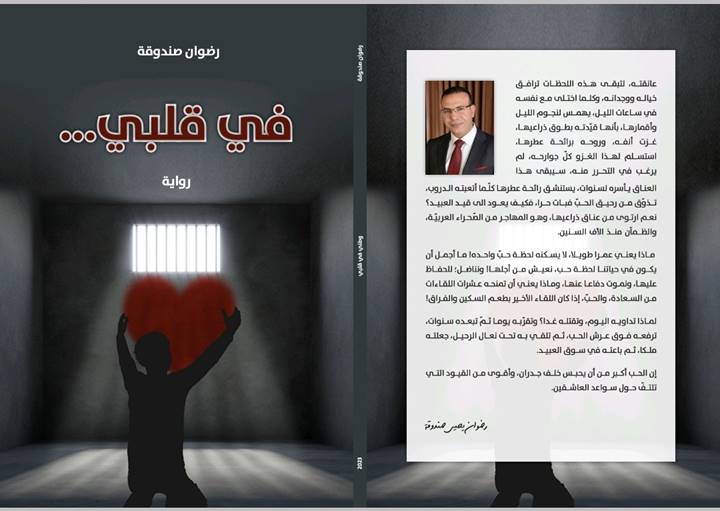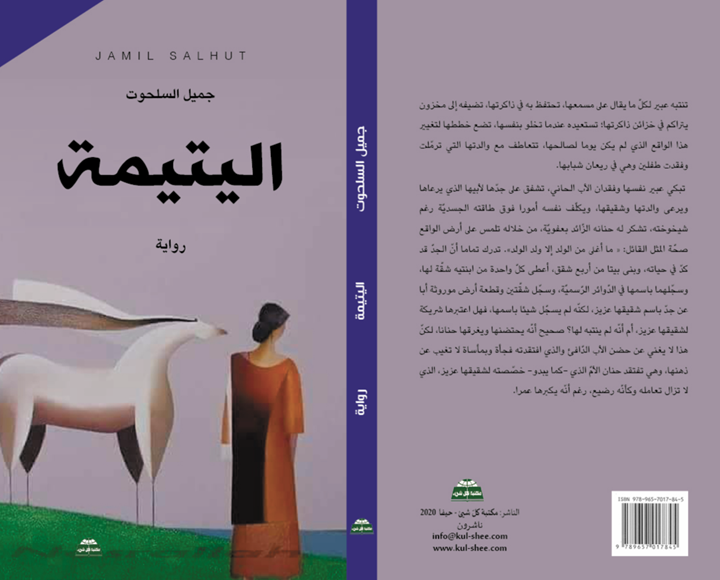القارئ الضمني هو ذلك القارئ الذي قد يقرأ العمل الأدبي ويقصده بمعنى آخر. هل فكر الكاتب بهذا القارئ؟ وكيف يمكن أن تكون ردة فعله؟ وأحيانا أخرى يتطابق القارئ والكاتب، وقد حدث الأمران معي.
آخرها ما أفاض فيه صديقي الكاتب والباحث الدكتور نبهان عثمان إثر قراءته لكتابي "مساحة شخصية- يوميات الحروب على فلسطين". يتصل بي الدكتور ويعبّر عن إعجابه بالكتاب وأفكاره وبأنني كتبت ما بداخله. في الحقيقة نحن نتطابق في أمور كثيرة أنا والدكتور نبهان، ولاحظت ذلك وأنا أعمل على تحرير كتابه الجديد "الثقافة الاستعمارية والألم البشري". يا لها من صدفة جميلة ومبهرة حقاً!
تحتاج إلى هذا النوع من القراء الكتّاب المثقفين الذين يمثلون مرتبة عليا من الوعي وامتلاك الرؤيا والفكرة، ثمة كتّاب أصدقاء أقرأ لهم ويقرؤون لي، أكتشف أننا نتشابه كثيراً. إنه جميل إلى حد ما، لكن لا بد لك من قارئ مختلف، يختلف معك ليثيرك ويشجعك على أن تنمّي مهارات التفكير والحجاج وتقليب الفكرة على غير وجه، بل ويدفعك إلى الشك بما تكتب لتعيد مراجعة ذلك. هذا النوع من القراء مفيد، وعبقري، وضروري لا سيّما إذا كان متربصا بك، يعتبرك الوجه المضاد لأفكاره.
إلى الآن لم أجرب هذا النوع من القراء بهذه الكيفية بحيث نشكل معاً حلقة من اتجاه معاكس على مستوى الفكرة ونقاشها. اقترب من هذه الصورة قليلا صديقان، الأول الكاتب السياسي عمر حلمي الغول الذي عارضني في كثير من الأفكار التي كنت أضمنها مقالاتي، وصل الأمر به إلى أنه كتب مقالة وافية في الرد على مقالة لي، ونشرها في زاويته الخاصة في جريدة الحياة الجديدة. وأما الصديق الآخر فهو الشاعر والناقد الدكتور المتوكل طه الذي ناقشني مطولا هاتفيا حول مقالتين، إحداهما حول المثقف وعلاقته بالسلطة، والآخر عندما وجهت له رسالة ضمن مقالٍ لمناقشته في فكرة طرحها في ندوة أدبية حول الأسرى الفلسطينيين ودورهم. كلا الصديقين رائع، ورغما عن اختلافهما معي واختلافي معهما في بعض الأفكار والتوجهات السياسية، إلا أن لغة النقاش كانت راقية، وتدل على أن الحكم هو الفكرة وليس التعصب.
أما خارج دائرة الأصدقاء، أي من خارج دائرة المعارف، فثمة كتاب وقرّاء تفاعلوا مع ما أكتب، وكانت آراؤهم محفّزة لي على أن أجد في ما أكتبه أهمية كبيرة، وقد أفسحت لهم ولآرائهم مجالاً في كتبي، مرسخاً بآرائهم أمرين اثنين، وهما: ديمقراطية الكتابة، بما تعنيه من حق الاختلاف، ومنهج النقد التفاعلي الذي أرى أنه من الواجب الأخذ به في كل كتاب جديد، لما له من أهمية نافعة في تصوير الفكرة وبحثها. وسبق أن أشرت إلى ذلك في مقدمة كتاب "الكتابة في الوجه والمواجهة"، وعدا هذا فقد خصصت كتابة غير هذه لبحث مسألة النقد التفاعلي كما بدا في تجربتي الكتابية، وخاصة النقدية، مبينا مظاهرها وورودها في كتبي، وأهمية أن يحافظ عليها الكتاب، ويولوها عنايتهم ففيها الكثير من المنفعة للقارئ والكاتب ومناقشة الأفكار سواء بسواء.
يمثّل هؤلاء- إذاً- نوعين من القراء، وثمة نوع آخر مختلف تماماً، هو ما سأتحدث عنه بالتفصيل فيما سيأتي:
في حالات نادرة، أشبه بالهدايا الربانية العظيمة، تمنحك الحياة قارئاً متفحصاً، نهماً، عارفاً، متيقناً من صنعته. نعم صنعته! ليست وحدها الكتابة هي صنعة، بل القراءة صنعة لا تقلّ أهمية عن صنعة الكتابة، و"القراءة عملية معقّدة" كما يقول إدوارد سعيد، لا سيّما القراءة التي يمارسها قراء من هذا النوع؛ الذين لا يطمحون أن يكونوا كتّاباً، ولا نقّاداً، لكنهم يعرفون أن الكتاب جيد، وجيد جدا، بل ممتاز، ويعرفون من خلال معايشتهم تفاصيل كثيرة عن الكتاب المقروء إلى الحد الذي يفاجئ الكاتب نفسه. إنهم فخورون بأنفسهم كونهم كذلك، يكشفون عن روح الكتب وروعتها، ويضعون أيضاً أيديهم على مواطن الخلل التي فيها.
لقد حباني الله- ككل الكتّاب- في حقيقة الأمر بأمثلة كثيرة من هؤلاء القراء المثقفين الذين هم أفضل عندي من النقّاد؛ الأغبياء أحياناً. أغبياء لأنهم حشروا أنفسهم في أسمائهم ونصوصهم، ولا يبحثون ولا يجددون، إنما هم يدورون حول أنفسهم كما يدور الثور بالساقية، ويعتمدون على اللغة النقدية الجاهزة التي تشعر القارئ بالغربة عن النص المنقود.
هؤلاء الأصدقاء يعرّفون أنفسهم بأنهم قراء، لهم مجساتهم الذاتية في الحكم على ما يقرأون؛ فهم لا يملّون من الكتاب، ولا يستطيعون التخلص منه إلا بعد أن يُتِمّوه لآخر جملة فيه، فلا يؤجلونه إلى وقت آخر، فيتحول إلى صديق ورفيق طوال الوقت، وقد يعيدون قراءته على مهل، ويدفعهم إلى متابعة البحث والتحري عن بعض ما جاء فيه، ليضيف لهم في نهاية عملية القراءة شيئا جديدا، مرسخا فيهم قناعاتهم التي شكلوها بفعل الحياة والتجارب، أو يُحدث لديهم قلقا معرفيا لأسئلة جديدة مقلقة، لعلها تساهم في خلق قناعات مغايرة. إنهم يتعاملون مع الكتب بجدية مطلقة؛ إن استطاع الكاتب أن يقنعهم بكتابه منذ الصفحات الأولى، أو من خلال الفقرة التعريفية على الغلاف الخارجي للكتاب.
إنهم يستطيعون أن يقولوا للكتّاب الكثير عن كتبهم: الشكل العام، والعنوان، ولوحة الغلاف، والأفكار، وتفاصيل صغيرة؛ في العبارات، واللغة، والألفاظ، والتراكيب، وثراء اللغة، وإحداث الدهشة، والمتعة، والجدية في التأليف، والرسالة المبتغاة. إنهم عارفون أيضا بمآلات الصنعة الكتابية في بعدها البراغماتي الذي يهم القارئ، وحركة الكتب والأفكار بين عموم المهتمين، ويجيبون ببراعة عن جملة من الأسئلة المتصلة بلبّ عملهم: لماذا يقرأ القراء؟ ولماذا يكتب الكتّاب كتبهم؟ ويعرفون أيضاً أين أخطأ الكاتب، وأين فشل الكتاب في تحقيق رسالته التواصلية مع القراء.
كل هذا حدث مع زميلة قارئة، نهمة، تحب القراءة، ولديها تاريخ طويل فيه، تشعرك كأنها مثل ألبرتو مانغويل في التمتع بفعل القراءة، تتحدث عن هذا الفعل بفرح كبير، كما يتحدث مانغويل نفسه. لقد قرأت زميلتي هذه كتاب "الكتابة في الوجه والمواجهة"، وعلى الرغم من أن الكتاب طويل، صغير الخط، مكتظ بالأفكار إلا أنها استطاعت أن تقدّم حول الكتاب أفكارها بوضوح كبير.
لهذه القارئة محدداتها، فأنا لم أكتب رأيي في المسائل المطروحة دون أدلة. في حقيقة الأمر كنت حريصا على أن أدعم وجهة نظري بالأدلة النقلية والعقلية، وأحافظ على إيقاع واحد للكتاب في المناقشة العقلية الهادئة المطمئنة. انتبهتْ إلى ما في الكتاب من أفكار صادمة، لقد أزعجها أن تصطدم بهذا الواقع المرعب للثقافة، وما يدور في كواليسها من امتهان للمرأة، وتشدّد على امتهان المرأة لذاتها، وتمهّد الطريق للآخرين لتكون ضحية تصوراتها وهواجسها وتطلعاتها. لقد كسر الكتاب- كما قالت- تلك الصورة النمطية الذهنية التي تشكلت لديها منذ تعلقت بالقراءة وتعرفت إلى الكتّاب والكاتبات، فكانت ترى الكاتبات قديسات وعظيمات، وفي مكانة رفيعة ومكان عَليّ. جاء هذا الكتاب وكسر تلك الصورة بأطرها كلها، وفتح الملفات السرية للنظر إلى هذا الواقع الثقافي العفن، لقد كان الكتاب كفيلا بأن يسبب لها اكتئابا طويل الأمد، منعها أن تكمل القراءة، وكانت تتحاشى أن يجمعنا الوقت والظروف خشية أن أسألها عن الكتاب ورأيها فيه. لأنها كانت في قمّة الإحباط.
أكدت لهذه القارئة أن هناك خفايا أشد وأبلى، ولم أتطرق إليها، لأنها ستجعل من الكتاب حاوية لخطايا الكتاب والكاتبات، ولأن الهدف ليس هذا بالتأكيد من الكتاب، واكتفيتُ بالإشارة وبينت ما أريد من أفكار بأمثلة محددة لئلا يتحول الكتاب إلى فضيحة ثقافية كبرى لوسط لا ثقافي، يعاني ما يعانيه من مشاكل أخرى هي أعظم من استغلال جنسي لكاتبة والتمتع بها من أجل إرضاء شهوة النفس الأمارة بالسوء لكاتب سمج وشهواني وعديم اللباقة والحس والذوق.
ماذا ستقول- مثلاً- عندما تعلم أن الكتّاب؛ بعضا منهم بالتأكيد تتأطر صورتهم في صورة أشخاص، أكثر انتهازية من أي شخص انتهازي آخر، مصلحجيون من طراز دنيء جداً، وأنهم في العموم ذوو مكائد وحسد ونفسية سوداء في تعاملاتهم البينية، وأنهم يشكلون فيما بينهم شِلَلاً طافحة بالغدر وسوء النوايا، ويتقنون أفعال النميمة الاجتماعية، وأنهم فشلة فكريون وكسالى، وانتقاميون، وكيف سيكون وقع الحقيقة عليها لو علمت أن من الكتّاب منافقين، وكذابين ودجالين، ونصابين، وعملاء مدسوسين، ومروجين للتطبيع، ويدافعون عن حلم الاحتلال والوجود التوراتي في الأرض المقدسة؟ وأنهم ماديّون لا يقدّسون سوى الدولار، ويطوّعون ما لديهم من مهارات وعلاقات مع المستوى السياسي من أجل تحقيق مصالحهم الصغيرة والكبيرة والفوز بالجوائز، والحصول على الامتيازات في الطباعة والسفر والمشاركة في الأنشطة الثقافية المهمة.
لقد اكتشفت دفعة واحدة على نحو صادم أن الكتّاب ليسوا أنبياء، وأن الكاتبات لسن قدّيسات، كما كانت تفكّر وهي بعدُ على مشارف القراءات الأولى لعالم الكتّاب الطافح بالخيال والرومانسية المثالية، وعلى أية حال كنت أشترك معها في هذا التفكير السابح في الصورة الفنتازية إلى أن دخلت هذا الوسط، وتعرفت إلى ما يدور فيه من كواليس ومكائد، وما يعتمل فيه من إقصاء وتشويه سمعة، وتدمير موهبة، وعايشتُ سياسة التعهير الثقافي من الكتّاب والكاتبات على السواء. وعرفت كيف تتم طباعة كتب الكاتبات الجميلات، وكيف يتم إشراكهنّ في المهرجانات الشعرية والمؤتمرات الأدبية في الداخل والخارج، وعرفتُ أيّ ثمن يدفعنه مقابل كل ذلك. وحتى لا تغضب مني جميع الكاتبات الجميلات من ذوات الصور اللامعة، والوجوه الحسنة والقدود الممشوقة والممتلئة، والصدور الفائرة الشهية، والأرداف اللافتة، وتحديدا الجميلات جدا، والأنيقات جدا، وصغيرات السنّ، أؤكد أن الأمر ليس عاماً، وليس هو قاعدة تنطبق على كل كاتبة أو شاعرة مشاركة في ندوة أو مهرجان أو طُبع لها ديوان، أو كتب لها "ناقد كبير" قراءة نقدية في أعمالها أو قدّم لها كتاباً أو ساهم في حفلات توقيع كتبها. فوجود العفن في أي وسط لا يعني انعدام اللبنات الصالحة والصورة المناقضة النقيضة لتكون أمثلة إيجابية.
تتجاوز هذه القارئة تلك الصدمة بعد نقاش طويل ومرهق، وتستعيد القدرة على إكمال الكتاب، فيدور حديث آخر بيننا، تعبّر فيه عن إعجابها بالكثير من التراكيب اللغوية، وتخطّ في نسختها تحت الكثير منها. بل وترى أن الكاتب يجب أن يكون له هذا الثراء اللغوي والمعرفي، وهذا الاقتران المدرك بفطرة الصنعة الكتابية "أن لكل موضوع ألفاظه وتراكيبه التي تفرض نفسها على الكاتب في لحظة الكتابة". أعجبتني جدا هذه الإشارة الذكية، وكأنها تومئ إلى ما يقوله النقّاد إن لكل كاتب معجماً خاصاً به، وإن لكل موضوع معجماً خاصاً به كذلك.
إنها بالفعل قارئة محترفة، فأنا أفعل ذلك أيضاً. وأنا القارئ المحترف، أقرأ الكتب منذ كان عمري 13 عاماً وإلى الآن. لا تنفع نسختي التي أقرأها أي قارئ بعدي لكثرة ما أخطه عليها وما أكتبه من ملاحظات، سبق أن قلت ذلك في تغريدة على توتير (21 سبتمبر 2017): "الكتب التي أقرؤها لا تصلح لأحد من بعدي، ولذلك أيضا لا أعير كتابا قرأته لأحد، فعليه ما عليه من صوتي الداخلي وأنا أقرأ". نعم إنه صوتي وحواراتي مع ذاتي، وكذلك الأمر بالنسبة لأي قارئ، ومع كل هذا، كم تمنيت لو أعطتني نسختها من الكتاب لأتأمل عملها القرائي؛ فأرى صنعتي الكتابية بين يديها على هديٍ من تفكيرها ولأسمع صوتها الداخلي، وأرى صورتي في هذا الصوت. إن هذا- وقد حدث- مذهل جدا، بحقّ، بل ومفرح فرحا لا حدّ له.
تزداد رغبتي في تعريف زميلتي هذه على كتب أخرى، فأمدّها بنسخة من كتاب "شهرزاد ما زالت تروي"، لما بين الكتابين من تشابه في الهدف، وإن اختلفا في طريقة العرض والتناول، فتأتي أيضا ملاحظتها دقيقة وعبقرية في نفورها من القراءات النقدية التي احتواها الكتاب.
لم تستسغ تلك القراءات، وشعرتْ أنها تقرأ عن أعمال أدبية غريبة عنها، فلم تفلح تلك القراءات بجسر الهوة المعرفية ما بين القارئ والقراءة النقدية، فثمة مسافة بينهما، لا تشجع القارئ على القراءة والاستمرار فيها، فهي لا تلبي شغف المعرفة، بمعنى أن الكتابة عاجزة وليس ناقصة فقط، هذا جعلني أفكّر بميزات القراءة النقدية الفاعلة.
أعتقد أن قراءات "شهرزاد ما زالت تروي" تختلف عن قراءات "الكتابة في الوجه والمواجهة"، فلم يظهر اعتراضها إلا على قراءات "شهرزاد..." النقدية. هل تطورتُ نقدياً؛ فثمة سنوات بين الكتابين تزيد عن ستّ سنوات؟ أم أنها هي من شعرت بالملل بعد أن قرأت كتابين لهما الرسالة ذاتها، وربما تقاطعت الأفكار بينهما في منطقة ما؟ هل كانت فلسفة المجموعتين مختلفة أم أن أحدهما تكرار للآخر؟ لقد سألتها عن هذا الهاجس بالتحديد، لأنني أريد أن أعرف السبب، فلم تكن المشكلة في الأفكار ولا في الأسلوب، فقد استمتعتْ بالفصل الأول غير المرتبط بالأعمال النقدية. النتيجة الأخيرة مع هذا الكتاب، لم تكمله، لأن الكتاب في هذا الفصل لم يستطع أن يكون كتابا معرفياً مستقلا بذاته، ظل يعاني من النقص والعجز، ولا يفيد إلا من قرأوا تلك الأعمال فقط والكاتبات اللواتي كتبت عن كتبهنّ، لأنهم وحدهم من يستطيع أن يفهم ماذا كتبت حول العمل الأدبي.
دفعتني ملاحظتها المتبصّرة إلى أن أعود إلى كتاب "شهرزاد ما زالت تروي" لأرى كيف كتبت قراءاته النقدية وأقارن بينها وبين قراءاتي النقدية في كتاب "الكتابة في الوجه والمواجهة". ثمة إسهاب واضح في الكتاب الثاني، جعل القراءة النقدية أوضح في فكرتها وإضاءتها على العمل الأدبي، إضافة إلى أنني في كتاب "الكتابة في الوجه والمواجهة" أوردت النصوص المدروسة مع بعض القراءات، وركزت على الاقتباسات في التحليل النصي للأعمال الأخرى، ما جعل القراءة مكتفية بذاتها في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى أنني في مقالات هذا الكتاب ركزت على موضوع التنظير النقدي الذي أسهبت فيه عندما تحدثت عن الكاتبات أو أعمالهنّ، وذهبت نحو تعميم الأفكار، وحررتها من الارتباط الحتمي بالنصوص المدروسة.
على أية حال، فإن ما توصلت إليه أيضا مع هذا الكتاب له أهمية نقدية بالغة القيمة، فهي أولا تؤكد ما قاله إدوارد سعيد في أن المقال النقدي لا يغني عن العمل الأدبي، وتوصلتْ إلى هذا الحكم النقدي بخبرتها في القراءة، وثانياً يدفعني رأيها إلى ملاحظة جسر الهوّة بين القارئ والمقال النقدي في المستقبل؛ إذ الأمر الذي يراودني للكتابة حوله، كيف تجعل القراءة النقدية تغني نوعا ما عن قراءة العمل الأدبي؟ أو على الأقل لا تجعل القارئ يشعر باحتياجه للعمل، ويشعر بنوع من عدم الانسجام مع القراءة النقدية. هذا كان أمرا بالغ الأهمية من أجل تجسير الهوة بين القارئ- أي قارئ-، والكتاب- أي كتاب- وخاصة الكتاب النقدي، وفيما بعد بين القارئ وبين المقال النقدي الذي يحلل أي عمل أدبيّ، ويُنشر مستقلاً في الصحيفة أو المجلة فلا بد من الإيضاح والعمل على جسر تلك الهوة المكتشفة. كانت تأتيني قبل هذا الموقف تعليقات على تلك المقالات ولم أكن أهتم بها، تعليقات لها هذا المضمون تقريباً، من مثل: "لم نقرأ العمل لنحكم على صحة القراءة أو منطقيتها".
بعد هذه التجربة توصلت إلى قناعة أنه من الضروري ألا يشعر القارئ أن عليه أن يقرأ الرواية أو ديوان الشعر محل الدراسة، وعلى المقال النقدي أن يُرِيَ القارئ الكتاب، فيحببه إليه أو ينفّره منه، لا أن يجعل بين القارئ والناقد هذه المسافة الداعية إلى قطع التواصل بين أطراف العمل النقدي: القارئ والناقد والمبدع. فالنقد هو الجسر الواصل بين الطرفين، ولا بد من أن يكون هذا الجسر مبنياً بخبرة مهندس فنان، بقراءة نقدية ممتعة ومكتملة الأركان، وعلى الجانب الآخر أسرّ عندما يقول لي أحدهم إنني صرت أكتفي بما كتبته عن أعمال الكتّاب لأحكم على جودتها، وهل هي جديرة بالاقتناء والمتابعة. هذا الحكم جاءني من شخصين مهمين بالنسبة لي، الأول أستاذي الدكتور عادل الأسطة، والآخر الصديق، شريك الأفكار الدائم الكاتب حسن عبّادي. فكلاهما يثق بما أقوله حول أغلبية الأعمال الأدبية، وإن اختلفنا؛ فاختلافنا في بعض الجزئيات، فأنا أحمل في داخلي بعض مميزات د. عادل في الطرح والمناقشة، فإن لم يرضَ عما أقول، فستعجبه- غالباً- طريقة التناول والبحث. وأما حسن فأنا أثق فيه كثيرا، ولذا فإنني غالبا ما أعرض عليه كتبي لمراجعتها قبل أن تصدر. وهو يفعل ذلك، فالكتابة والقراءة بيننا قسمة وتفاعل.
هذا النوع من القراء يمنح الكاتب جرعات من الأدرينالين الذي يضخه في دمائه، فيزداد ثقة على ثقة. أنا- وكل الكتاب- بحاجة إلى مثل هؤلاء القراء الذي يكشفون جماليات ما نكتب. فيعطوننا الرغبة في زيادة العمل ومواصلة المشوار، لأننا بالفعل نقوم بعمل يستحق كل هذه المكابدات والتضحيات بالوقت والجهد والمال.
ترى هذه القارئة الشغوفة بالجمال أن الكاتب يكتب "لنا نحن القراء"، وهذا حق وعدل، فهذه الجموع القارئة التي تلتهم الكتب وتحرص على اقتنائها، هم من يصنع مجد الكاتب وحياته وحيويته وشهرته، ولولا هذه الجموع، لا معنى لوجود الكاتب، فلا كاتب يكتب للفراغ، ولِلّاشيء.
عليّ أن أعترف اعترافا صغيرا، لكنه فاضح، أن بيئة العمل التي أعمل فيها محبطة، فالزملاء لا يقرأون، لا كتبي ولا كتب غيري ولا حتى الكتب الرسمية ولا التعليمات وربما لا يقرؤون الكتب المقررة التي عليهم التعامل معها يوميّا في الميدان، فهم لا يجددون ولا يتجددون، على الرغم من أننا- نحن المشرفين التربويين- من أكثر الموظفين حاجة للقراءة بحكم عملنا التربوي اليومي المتجدد المفتوح على الأفكار وتنوعها واضطرابها. فمنذ ما يقارب 28 عاما عملت فيها في وزارة التربية والتعليم معلما ثم مشرفا تربويا لم أجد في هذا المحيط قارئا جديا سوى أربعة قراء أو خمسة على أبعد تقدير، ومن سوء ما فعلتُ أنني أهديت بعض كتبي إلى زملاء لا يستحقونها، فقد "دحشوها" في أدراج المكاتب، أو بين أوراقهم المهملة، وكنت أرى منظرها وأتـألم، ما دفعني إلى أن أسترجعها، ولم يحدث أن راجعني زميل ليسأل عن نسخته التي تكون قد ضاعت في هذه الحالة. أظن أن الفرَج قد جاءه من غامض علم السماء ليخلصه من هذا الذي حمّل حمله!
تأتي هذه القارئة لتعدّل كفة الميزان، وتقدم لي هذا الذي يطلبه أي كاتب في الكون؛ الاهتمام بكتابه، وقراءته بوعي فكري وبلاغي متقدم، ومناقشته، والتعبير عن الفرحة بقراءته، وأنه كان كتابا جيدا، ومفيدا، ولا بد من أن يُقرأ؛ لأن فيه ما يستحق القراءة، هذا النوع من القراء يستحق أن يكافأ بالمزيد من الكتب الجيدة، وهكذا فعلت وسأفعل دائماً مع كل قارئ جيد يُرضي طموحي، ويسعدني، فمن حقي ككاتب أن أنحاز لمن ينحاز لي من القراء العظماء، ولن أملّ من البحث عن أمثال هؤلاء، لأبذل لهم كتبي عن طيب نفس، طمعاً في توثيق علاقتي بهم كقراء أصدقاء يعرفون للكاتب حقه، ويقدرون بصنعتهم العبقرية هذه صنعته التي يطمح لها أن تكون عبقرية لتتناغم العبقريتان في الهدف وفي النتيجة. فمعاً وسويا من أجل كتابة فاعلة وقراءة أشد تفاعلية.