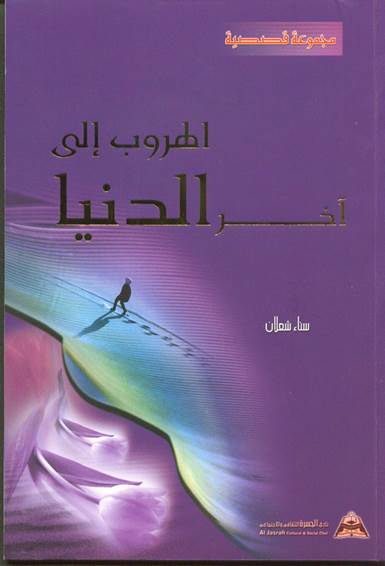*ملاحظة : هذه المقالة هي جزء من مخطوطة كتاب للكاتب عنوانه "محبرة الخليقة" كان المبدع الراحل جوزف حرب قد اتصل هاتفيا بالمؤلف من بيروت قبل رحيله بأيام مبديا إعجابه الشديد به وعازما على طبعه. يدور الكتاب حول ديوان جوزف حرب "المحبرة" الذي دخل موسوعة غينيس لكونه أضخم ديوان في العالم (1750 صفحة). وهي تحية إلى روحه لكونه عاشق كبير للعراق وهو ما لمسته من خلال لقاءاتي الشخصية به.
(هي الأرضُ ،
خاليةٌ ، خاويهْ ،
كمعصرةٍ ، ليسَ من عاتقِ الخمرِ
فيها ،
سوى خابيهْ ،
تنامُ بفخّارها
عَتمةُ الزاويهْ )
... و"الرائعة" هي قصيدة المفتتح في ديوان المبدع "جوزف حرب" "المحبرة" الذي يقع في (1725 صفحة) ، وتتكوّن من أحد عشر مقطعا ، ويستهلها الشاعر كما يأتي :
(يديْ
ريحٌ
وطاولتيْ سوادُ الليلِ ، والأوراقُ غيمٌ
عن يمينيْ ، قربَها أقلامُ صندلةٍ ، ومحبرةٌ تقطّرَ
حبرُها الكحليُّ
من ماءِ البنفسجِ
عنْ
يَساريْ
شمعةٌ من فضّةٍ ، يدعونها : قمراً ،
ولي كرسيّ أيلولٍ ، خفيف الحَور ، أجلسُ فيهِ
مستنداً إلى
قُزَحَيْ سَحابهْ
وظهرِ عريشةٍ
عند الكتابهْ – ص 11 و12) .
وهذه جلسة أسطورية خارقة "يرتكبها" شاعر من عصرنا ، تخرق حدود الوجود الفردي/ وجودنا البائس الذي تتسع دائرته هنا لتشمل الكون كلّه ، جلسة مشرفة من علٍ ، تتحكّم بالريح وسواد الليل والغيم وماء البنفسج والقمر .. كرسيّه الزمان .. مسنده قوس قُزح السحاب ، ومتكأ ظهره العرائش ، ومسترخياً عند الكتابة .
وإذا كان الشاعر "العادي" يوصف بأنه ابن الطبيعة لأنه يمتح من روحها وصورها ويخلص لقوانين نمائها ، ويتمثل حكمتها وهذا هو الأهم ، فإن شاعرنا هنا هو "أبو الطبيعة" ، أو هو طبيعة كبرى كونية هائلة ؛ يتجسد هذا في "مكتب" إبداعه ومستلزمات كتابته : فيده الريح ، وطاولته سواد الليل ، يخطّ على هذا السواد الكوني قصائده بأقلام الصندل على جسد ورقة الغيم ، بحبر كحلي تقطّر من ماء البنفسج . أما شمعته التي يستهدي بها في عمله الذي يبدأ عادة في الليل فهو : القمر ، وأمّا زمانه ووقت فعله ، فهو وقت قدوم الربيع الباهر حيث صمت الولادة لا يقطعه سوى حفيف الحور .
إنها أجواء ومناخات أسطورة مهيبة ومقلقة نسبيا . وفي جلسته المسترخية هذه يدخل على الشاعر خادمه : السنونو ، يطلب منه الإذن بدخول رسول عليه هو : الملاك . رعيّة الشاعر سماوية لا أرضية ، وبدخول الخادم السنونو نبدأ حكاية عالم الشاعر بإشكالية خلق . وحين نقول "حكاية" فليس الوصف هنا معنويّاً حسب ، بل لأن السمة الحكائية السردية تهيمن على ديوان "المحبرة" بأكمله . فنحن أمام قصّة للخلق والخليقة والكون والحياة والإنسان كما سنرى .
يدخل الملاك بغموضه الباهر المشوّش ، وبخفّة لون مّربك خلطته أنامل وحساسية فنان لم يشهده تاريخ الأرض كـ :
(غامضاً كالزرقةِ الملأى مساءً)
وهنا تتضح عظمة "الكلمة" ، فلو جئت بأعظم رسّام في التاريخ ، وطلبت منه أن يجري بفرشاته وأنابيب ألوانه هذه الخلطة المعجزة : أزرق مملوء بالمساء ، يتضبّب بالزرقة فيلفّه غموض الكينونة - ولعل جوهر بداية عملية الخلق كلّها هو بهذه الصيغة الجنينية اللونية والتركيبية - أقول لو جئنا بهذا الرسام ، ومهما كانت درجة عبقريّته ، لأعلن عجزه فورا عن التعبير عن مثل هذا المشهد الخارق بتركيبيته ، مثلما لا يستطيع تصوير صرخة أم مثكولة جارحة ؛ قد يصوّر تعابير الصرخة على وجه الأم ، لكن الصرخة نفسها ، لا يمكن تصويرها إلا بأداة من "جنسها" وهي هنا "الكلمة" . إن كلّ ما هو مادي يحدّد إمكانيات "التشخيص" ؛ تشخيص المجرّد ، ويضيّق من قدرات "التصوير" . ومن المفارقات الصعبة التي يتمأزق بها العقل البشري ، هي نزوعه المستحيل لتصوير ما هو مجرّد بما هو مادي !! ولعل هذا واحد من أهم اسرار موقفنا المسلّم بعظمة الصانع الأكبر حين يعلن عقلنا عجزه السافر عن تصويره ، كما أنه – من ناحية أخرى مكمّلة – من دوافع موقف المرجعيات الدينية المتصلّب والشاجب لعملية التصوير عموما ، والذي بدآ خطوته الأولى في التوراة ، فأن تقوم بـ "تصوير" الأشياء من دلالاته المستترة ، معناه أنك "تخلقها" أو "تعيد إنشاءها" في صورة أحسن ، وأن تحاول أو تستطيع تصوير الذات الإلهية ، فهذا يعني أنك مثلها ؛ كفؤها وندّها ، وهل لهذا اختار الله صفة (المصوّر) كواحد من أسمائه الحُسنى ؟ وهل هذا هو سبب كره الآلهة للشعراء الذين شُغْلهم الأساسي هو "التصوير" ، لا باللون المحدود الإمكانات ، ولكن بالكلمة الخارقة التي تحيي وتُميت ؟ :
( تقدّمَ مرّةً منّي السّنونو
خادمي
قالَ :
الملاكُ .
فقلتُ :
فليدخلْ .
فأقبلَ لابساً فوفَ الصباحِ ، أخفّ
من نومِ الخُزامى ، غامضاً كالزُرقةِ المَلأى
مساءً، حاملاً مخطوطةً من ستّ غيماتٍ، ومكتوباً
بمنديلٍ ، وقال :
الكونُ حمّلنيهما سرّاً إليكْ – ص 12 و13) .
وقد يتساءل القاريء : من أين جاء الشاعر بمفردة "فوف" ، وكيف عنّ له ربطها بمفردة "الصباح" ، فأقول إن هذه من السمات الأسلوبية لجوزف حرب ، حيث تجد في كل شعره هذا العناء والدقّة الهائلة في البحث عن المفردة المناسبة وانتقائها من بين عشرات المفردات المرادفة لها في محيط اللغة . ولعلني لم أكن دقيقا حين اخترت مفردة "البحث" ، فهو – وأي شاعر "محترف" مقتدر صار الشعر مفتاح منظوره إلى الموضوعات ، وروح رؤيته إلى الكون والحياة ، أي صار "اختصاصه" - هو - وحسب التعبير الدقيق لبيكاسو - لا يبحث ، ولكنه "يجد" . إنه مخزون اللاشعور العارم والمكتظ بالمفردات المتحرّكة في صلتها بالأشياء لتنغمر بدلالاتٍ يعود أغلبها إلى عوامل انفعالية وعاطفية واستعارية لا صلة لها بالمعنى القاموسي ولا بالمعنى الإستعمالي والتداولي للمفردة . ولو سألتني هل كان جوزف يعلم أنَ من معاتي الفُوفُ : الحبَّةُ البيضاءُ في باطن النَّواة تنبت منها النخلة ، والقِشْرُ الرقيقُ يكون على النَّوَى ، وثيابٌ رِقاقٌ مُوَشَّاةٌ مخطَّطة بخطوط بيض طوليّة ، وأنها تعني ، ايضاً ، قِطَعُ القُطْنِ ؟ فأجيبك بأنه لم يكن يعلم بكل تلك المعاني ، ولكنه "وجدها" فيها من خلال بنية الكلمة ، وجرسها الموسيقي ، وطبيعة حرف الفاء "الشفّاف" والمهموس الذي لو استعدت حركته ، متخيلا إياها وأنت مغمض العينين ، لأحسست أن حركته تشبه ملامسة ثياب النور لجسد الصباح ، وهذه الثياب هي فوف الصباح البيض التي ستناسب طبيعتها التركيبة الغامضة و "العطرية" لكيان الملاك الذي سلّم "الأمانة" للشاعر ، وانطلق تتبعه موجات من فوح الآس والغار .
والأمر تفسه يُقال حين تتأمل موقع الفعل "مرى" ، الذي وصف به الشاعر خفقة جناحي الملاك المودّعة في ختام هذا المقطع :
(..
ولوّح للسنونو بالجناحينِ
اللذينِ مَرَى بياضَهما ،
وطارا – 13) .
فقد يرتبط أحد معانى هذا الفعل – إذا لم تكن تعرف دلالاته القاموسية – بالمرآة ، أي أن الشاعر نحت "فعلاً" ليدلّ به على الطبيعة الصقيلة الشاهقة لبياض الجناحين . لكني أحمل في ذهني واحدة من دلالات هذا الفعل : مَرَى الرِّيحُ السَّحابَ : أنزلت منه المطر . وقد يرى بعض السادة القرّاء أن هذه المحاولة توغل في التعمية وغموض الدلالة . ولكني أراها تأويلا مناسبا لكن ذو حدود ، وهذه الحدود مطلوبة لكي نلجم فوضى "استجابة القاريء" حين تكون بلا ضوابط ، وهذا ما يوصلنا إليه المنهج التقويضي (التفكيكي) . فلابدّ أن يرتبط التأويل بالسياق العام ، وبالمعقولية الشعرية ضمن إطار الصورة الكلّية فمهما حاول البنيون أو التفكيكيون ونقاد منهج استجابة القارىء ، اللعب على أوتار التأويل ، ولعبة فصل الدال عن المدلول .. إلخ ، فإن ما يمكن لأي أحد - حتى لو كان من سكّان المريخ - أن يلاحظه هو تماثل المعنى الشديد ويقينيّته . فلو قرأ مليون قارىء الرواية الجاسوسية ذاتها (مثل العميل رقم 7 لإيان فليمنغ) لافترض كل واحد منهم أنها قصة عن الجواسيس . ولن يخطىء أحد منهم فيخلط بينها وبين كتاب في الكيمياء الكهربائية . أمّا لو كان المعنى نتاجاً للتأويل لتوقّعنا أن نجد بعض النقاد ممن يرون أن "الدكتور لا" كتيّب في الكيمياء الكهربائية ، وأن جيمس بوند اسم مادة كيمياوية . وما يمكن للمريخي أن يقوله هو أن للنصوص سمة مميزة تتمثل في أن لها معان متقنة ومحددة مرتبطة بها ، وأن هذا واحد من الأشياء التي تميزها عن الأشياء الثقافية الأخرى ، مثل أحجار البناء والناس ، التي ليس لها مثل هذه المعاني . ويبدو أن المعنى المتاح للعموم في نص من النصوص يحدده موضوعيا ترتيب محدّد للكلمات التي يشتمل عليها هذا النص ، واللغة التي كُتب بها ، والأعراف التي تقرر كيفية قراءته ، والإحالات السياقية (إلى أوضاع واقعية ، أو إلى نصوص أخرى) التي يمكن لهذا النص أن يطلقها في أزمنة محددة وفي سياقات قراءة محدّدة . (أحد الأمثلة على سياق من "سياقات القراءة" هو استشارة دليل الهاتف ، ومثال آخر هو فراءة المرء قصيدة من أجل المتعة) . وعليه يمكننا أن نصرف النظر ودون ضرر عن ذلك التناول الذي يرى أن كل قراءة هي تأويل وحسب ، وأن ما من قراءة موثوقة أكثر من غيرها ، كما لو أن من الممكن ومن المشروع أن نقرأ "مرتفعات وزرنج" بوصفها دراسة رصينة في الحبّ السحاقي في الصين في القرن الرابع عشر . فهذه النظرة إلى التأويل هي طريقة الشخص ذي العقل الكسول في التأكيد على أن ما من شيء مهم لكي يتم تفسيره (4) . ووفق هذا المفهوم ، وفي هذا النصّ الشعري ، وتحديداً في هذه الصورة منه ، وحسب البنية النحوية للجملة ، يكون الملاك فاعلاً يستمطر بياض جناحيه الآسر بخفقاته العالية ، مثلما يتسق مع رداء الجسد الملائكي : فوف الصباح الأبيض ، بل مع الحرّكة الكلّية الخفيفة التي عبّرت عنها المفردات التي حكمها حرفا الفاء والخاء ، ومع حركة التسليم والحمل والتوديع الرقيقة التي تكفّل بها حرف الحاء ، وليس أيّ تأويل آخر :
(...
أخفّ مِنْ نومِ الخزامىْ .. وقالَ :
الكونُ حمّلنيهما سرّاً إليك .
وخفّ نحويْ
طافراً بهما ، حملتهما علىْ قوسِ اليدينِ ، فهفّ نحوَ
البابِ وهو مفوّحٌ
آساً ،
وغارا ،
ولوّح للسنونو بالجناحينِ ... إلخ) .
ولأن الشاعر كان قد رسم أمامنا مستلزمات عمله في مكتبه الشعري الخلاقي ، ومنها أن أوراقه هي الغيم حيث البياض والخفّة والحركية الإنتقالية المسترسلة ، وطابع الرسالة الإستعاري ؛ فالغيم رسالة ، وقد جاء الملاك حاملاً رسالة الكون السرّية ، مخطوطة من ستّ غيمات.. ومكتوبا بمنديل ، ولا تناشز في المكتوب ، فالمنديل "غيمة" وداع المحبّين ، وسحابة دموعهم الصغيرة الدافئة . وقد "حمل" الشاعر، حانياً، المكتوب والمخطوطة اللذين "حمّلهما" الكون للملاك ، بـ "قوس اليدين" المرهف . كلّها "حركات" متسلسلة هادئة وشفيفة .. والأهم "متّصلة" ، هذا الإتصال والديمومة التي عبّر عنها "رمزٌ" وُشّح الكونُ به المنديلَ المكتوب ، هو "جناح عصفور" محاط بفواصل وليس بنقاط . يؤوّل الشاعر هذه "الشفرة" الرمزية التي صاغها الكون بأن الفواصل تشير إلى وحدة هذا الكون الدينامية .. إلى أن كلّ شيء في تواصل وترابط .. لا توجد حدود عازلة ، ودوائر وجود حديدية . الكل يتفاعل بالكل وينفعل به . وهذه "المقدّمة" الإشارية هي روح الرؤية الشعرية التي تنطلق من وحدة مكونات الكون والحياة وتداخلها وصولاً إلى تراسلها الثر . ولا يمكن أن يكون هنك شاعر إن لم يتسلح بهذه النظرية "الإحيائية" والترابطية الملتحمة . فكل ما في الكون حيّ وذو روح تتيح له ديمومة الحركة الحيوية والترابط العضوي الفاعل مع المكوّنات الأخرى بالتحام تبادلي مستمر .