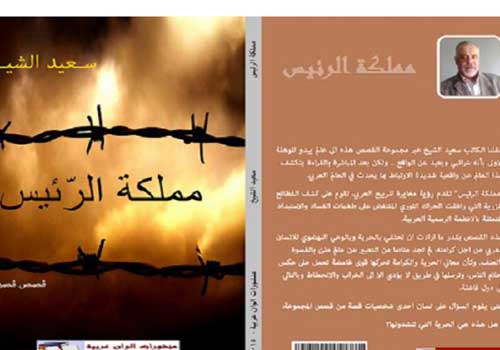تنطلق الرواية أحيانا من خبر أو حدث خاص أو عام، يطوّره الكاتب ويتخذ منه أحيانا حاملا للسرد ثم ينطلق إلى سرد الواقع أو التجربة الحياتية فيه، بأسلوب ينقل الواقع كما هو أحيانا، وأحيانا ينجح في تخييل ذلك الواقع، بفنيّة عالية أحيانا ومتواضعة أحيانا أخرى، ما يُؤدّي إلى تأرجح الرواية بين اتجاهات مختلفة، فقد تخرج الرواية كرواية وثيقة، أو رواية تسجيلية، ولكن، ما من رواية أو روائي لا يطمحان إلى أن ملامسة الرواية الفنية بكثير من جوانبها. فينجح الكاتب، وبتواضع أحيانا، في أن يُضفي بعض الملامح الفنية على روايته دون ينجح في صرف نظر القارئ عن كونها رواية تسجيلية أو رواية وثيقة، نجح فيها بتوصيف التجربة المعيشة وتوثيقها بشكل يطغى على فنيّة الرواية. وهذا ما وقعت فيه الكاتبة خلود رزق خوري في روايتها "أمل في الظلام"، رغم أنّها لم تتناول الحدث طازجا، ولم يكن ذلك ممكنا أصلا، لانتشار الحدث أو التجربة أو الحكاية على مساحة زمنية امتدت عددا ليس بالقليل من السنين، فرضت على الكاتبة اتخاذ مسافة بين بداية الحدث على الأقلّ، أو التجربة، وبين تحويلها إلى تجربة روائية لها أهداف توثيقية وتعليمية واضحة، ارتبطت بانطلاق الكاتبة من واقعها الذي تكتب له وتحرص على أن يستفيد من تجربتها لتخفّف المعاناة عن المجتمع عامة، وعن بنات جنسها خاصة، في حال وقوعهن في تجربة مماثلة لتجربتها. فهي تُدرك أن تجربتها الخاصة، يُعاني منها آخرون تعرفهم أو لا تعرفهم، وهو ما يظهر في بعض إهدائها حين تقول: "إلى رفيقتي في معاناة مشتركة ... حنين ...". فقد أدركت خلود أنّ تجربتها، رغم خصوصيّتها، ستتحوّل يوما ما إلى تجربة عامة، وذلك لكثرة الحدوث وتعدّد الحالات الخاصة، ما يعني أنّ الكاتبة أرادت توثيق تجربتها التي عاشتها وعايشتها في تجارب الآخرين، لتكون خطوة وقائية يستفيد منها الآخرون. فهي تُهديها أيضا، "إلى كل أمّ عربية تتعرّض لمصاعب حياة بلا سابق إنذار". وكما ظهر ذلك في الإهداء، يظهر واضحا أيضا في أحداث الرواية.
لم أكن أعرف شيئا عن مرض التوحّد الذي يُصيب الأطفال أو يُولد معهم. ولكنّ الآن، بفضل تجربة خلود التي أتمنى لو لم تمرّ بها كتجربة حياتية، وبفضل روايتها، صرت أعرف عن ذلك المرض، لدرجة أنّني إن لم أستطع مساعدة من يعيش معاناة مشابهة، فعلى الأقلّ أستطيع توجيهه إلى خلود أو إلى روايتها، للاستفادة من تجربتها وللاستمتاع بقراءة الرواية، وللتعاطف مع قصة مغرقة في إنسانيتها.
شدّتني عتبات النص على اختلافها لقراءة الرواية. وجدت بعد ذلك أنّ معرفة المعلومات التي كنت أجهلها، رغم أهميّتها، لم تكن هي ما لفت انتباهي في الرواية، بل تلك المعاناة اليومية التي عاشتها الأمّ ونقلتها الكاتبة بصدق، وذلك الألم الذي رافقها، متوسلة بعض التقنيّات الفنية التي شدّت الحبكة، وإن لم تمنع ترهّلها أحيانا.
يحتوي مضمون الرواية على موضوعين أساسيين هما: مرض الطفل ومعاناة الأمّ، تنبثق عنهما مواضيع أخرى كثيرة ترتبط غالبا بالعلاقات الاجتماعية التي تتطوّر وفقا لتطوّرات المرض والمعاناة.
الطفل ومرض التوحّد
قد يمرّ الإنسان في حياته بتجربة المنفى بأقسى أشكالها، سواء كان المنفى طوعيا أو قسريا. ولكن، أن يولد الإنسان منفيا عن محيطه وعالمه الخارجي ويبقى سجين ذاته يرفض أيّ اتصال بعالمه الخارجي، حتى مع أقرب الناس إليه، أمّه، فقد يكون ذلك أقسى أنواع المنفى. فمن جهة، نحن نشهد رفضه لعالمه الخارجي، ونجهل كيف يواجه منفاه وعالمه الداخلي، ومن جهة أخرى، يدفع الآخرون ثمن تجربته فيتحوّلوا هم أيضا إلى منفيّين، قسرا واختيارا معا، بسبب تجربته هو. تلك التجربة التي تفرض عليهم اغترابهم عن ذاتهم وواقعهم.
يظهر رفض الطفل لعالمه الخارجي في بداياته، بإرجاعه الطعام أي بالقيء. فالقيء في الواقع هو رفض الطعام وقذفه خارج الجسم، ولكنّه روائيا، لا يقف عند هذا الحدّ، فهو رمز يُحيل إلى الرفض، رفض الآخر والعالم الخارجي والاكتفاء بعالمه الداخلي، أو يوهمنا بذلك على الأقلّ. تُصوّر الكاتبة ذلك وتربطه بشكل جيد ببداية معاناتها حين تقول: "فمنذ الساعة الأولى رفض أن أضمّه إلى صدري لأسقيه حنان الأمومة، وفضّل غذاء اصطناعيا ليرجعه في الساعة الثانية على ثيابه" (أمل، ص 16). كان في ذلك إشارة للأمّ أنّ شيئا ما ليس طبيعيا لدى طفلها، ولكنّها مسيرة طويلة من المعاناة، دامت حتى اكتشاف المرض وتفاقمت بعده. سلسلة مضنية من الزياراتن للأطباء والمراكز الطبية والأخصائيين، يكتنفها الجهل أحيانا، واللامبالاة أحيانا أخرى، إلى أن تصل الأمّ والعائلة إلى تحديد المرض، لتأخذ المسيرة شكلا آخر لا يقلّ قسوة عمّا كان. تبدأ عملية البحث عن طرق للعلاج، وتتحوّل لاحقا إلى عملية بحث عن طرق للتعايش مع مرض التوحّد الذي لا علاج محدّدا له. ولكنّها الأمّ، بعاطفة أمومتها، تنكر ذاتها وتواجه القدر وتعيش المعاناة وكل أصناف العذاب من أجل لحظة رضى أو بسمة أمل ترسمها على شفاه طفلها.
توحّد الطفل، المنفى السلبي للأمّ
المدخّن السلبي هو من يُعاني بلا إرادة، نتيجة ما يفعله المدخّن الفعلي. وهناك بعض الآراء العلمية التي يقول أصحابها بأنّ أضرار التدخين السلبي أقسى على المدخّن السلبي منها على المدخّن الفعلي. وحتى لو كان ما تقدّم صحيحا، فإنّ ذلك لا يُساوي شيئا بالمقارنة مع معاناة أمّ، لم تختر منفاها وإنّما قسرته على نفسها أو قسره عليها منفى وليدها. وأكثر من ذلك، فالمدخّن السلبي يُمكنه في لحظة ما، أن يقوم ويرحل مبتعدا عن المدخّن الفعلي. ولكن، هل تستطيع أمّ أن تقوم وترحل لتخلص من منفاها الاختياري، الذي قسرته على نفسها أو قسره عليها، المنفى الفعلي الذي يعيشه وليدها؟ إنّها تدفع نفسها دفعا إلى المنفى والاغتراب عن واقعها وحتى عن ذاتها التي تُنكرها من أجل أن تخلّص وليدها من منفى قسره القدر عليه وعليها.
حياة خلود، أو بطلة روايتها، تحوّلت إلى منفى قسري بسبب منفى وليدها. فمن الساعات الأولى لولادته بدأت تستشعر منفاه وترسم هي منفاها القسري وتربط حياتها ومنفاها بحياة وليدها ومنفاه. تقول: "فمنذ الساعة الأولى رفض أن أضمّه إلى صدري لأسقيه حنان الأمومة، وفضّل غذاء اصطناعيا ليرجعه في الساعة الثانية على ثيابه، تلك الثياب التي أعددتها خصيصا لأصطحبه وهو يرتديها عند عودتنا لبيتنا الذي أعدّ لاستقبال الزائر الجديد بكل ما تحمله فرحة الاستقبال لكل زائر منتظر" (أمل، ص 16). ولكنّها استبدلت ثياب وليدها المرغوبة التي تُحيل إلى الفرح بثياب مرفوضة أسلمتها للحزن، ما يعني أنّ حالة وليدها قسرت عليها استبدال فرحها بمجيئه، بحزن ولّده مرضه الذي منع تواصله مع أمّه وعالمه الجديد، حين تقول: "حزنت كثيرا ولففته في ثياب خُصِّصت للمواليد الجدد الذين يُقيمون في المستشفى فقط" (م. ن.).
وتدخل الأمّ، وحدها في بداية الأمر، منفاها الحزين الذي لا يشعر به غيرها. تقول: "عدنا أدراجنا إلى البيت، وبسمة عريضة تحتلّ وجه زوجي الذي عاش فرحة الحياة حين ناديناه بأبي وسيم، ولم يلحظ الخوف الظاهر في عيوني" (م. ن.). التركيز لاحقا على من وقفوا إلى جانبها في مأساتها، تعني إظهار مدى حاجة الطفل وأمّه، أصحاب المعاناة الأساسيين، إلى التعاطف معهم، وأهميّة المشاركة في تخفيف المعاناة. ومن جهة أخرى، تعني مدى أهمية تصرّف الآخر، لا لنزع المنفيّ من مأساته لأنّ ذلك غير ممكن، وإنّما للتخفيف عن المنفيّ ليصبح قادرا على تحمّل مأساته والتعايش معها.
تبدأ المعاناة التي تطلعنا عليها الأمّ، بطلة الرواية، عبر الذاكرة، لتمتدّ كما تقول: "أربع عشرة سنة مرّت، هي عمر ابني وسيم، الذي جمع بين دموع الآن وقهقهة الزمان" (أمل، ص 19). استشعرت المأساة في بدايتها ولكنّها كما تقول: "لم أدرك في ذلك الوقت حجم المأساة التي ستواجهني أو التي أواجهها. يبدو أن الأيام التي تنتظرني ستكون شاقّة أكثر" (أمل، ص 17). ولكنّها لم تستسلم، ووطّنت نفسها على المواجهة، وأخذت تعدّ أسلحتها، "ولكنّني كنت عازمة على حماية وليدي المبتسم الذي انتظرته طويلا ... أجهّز نفسي وأعدّ الأسلحة كي أحارب حالة لم أسمع عنها من قبل، لكنّي عشتها بحذافيرها لحظة بلحظة" (م. ن.).
ورغم الاستعداد والمواجهة، تظلّ محنة خلود، أو محنة بطلة روايتها، هي محنة الإنسان الذي يقف عاجزا أمام المجهول الذي يرسمه القدر. يظهر عجزها واضحا في تساؤلها: "هل من عدل القدر أن أكون أمّا لا تسعد "بنغنغات" وتلعثم حروف مولودها" (أمل، ص 18). ولكنّها أصرّت على مواجهة قدرها بشجاعة، وهي تُدرك أنّها لن تهزمه، ولكن، لعلّها تخفّف شيئا من قسوته على ابنها وعليها.
وتستمر المأساة وسبل مواجهتها بما فيها من مشاعر إنسانية نبيلة، ومواقف لا تخلو من عتب على لامبالاة المجتمع بهموم الآخرين، إلى أن تجد خلود ملاذها الأخير، وخلاصها في الكتابة، تتصالح بها مع ذاتها، وتنقذ روحها بفعل إنساني نبيل، يستفزّ المجتمع يطمح إلى إنقاذ الآخر الذي يمرّ بتجربة مماثلة.
مواضيع أخرى تكشفها المأساة
تدرك الكاتبة أهميّة لفت نظر القارئ، وخاصة ذلك الذي يمرّ بمعاناة شبيهة بمعاناتها، إلى ما قد ينشأ من تطوّرات جانبية، وعلاقات سلبية أو إيجابية، تخلقها المأساة وتتأثّر بها سلبا أو أيجابا.
عالم الأطبّاء، كغيره، مليء بالجهلة والأذكياء، باللامبالين وبالمتماهين، بالحاذقين لمهنتهم أو السطحيين الذين يدّعون المعرفة. وبقدر هذا وذاك، يُؤثّر عملهم وطريقة سلوكهم على المريض ومرافقيه، فيساهمون بتخفيف المعاناة أو بتفاقمها. وهكذا هو الأمر في عالم الأقرباء والأصدقاء والناس عامة. ينعكس ذلك في أكثر من شخصية تقف من البطلة ووليدها، موقفا سلبيا لامباليا يدفع إلى الإحباط واليأس، أو موقفا إنسانيا نبيلا وداعما، يدفع إلى التفاؤل ويشحن صاحب المعاناة بطاقات يكتشفها في نفسه بسبب ذلك الموقف الإنساني النبيل.
وفي الرواية تظهر أيضا بعض المواضيع الاجتماعية وغيرها، لا أظن أنّ خلود أقحمت بعضها بشكل واعٍ، وإنّما تحت تأثير المعاناة، وإلّا لم تكن لتجعل لمولودتها الأولى ذلك الدور الثانوي الذي يظلمها به المجتمع الذكوري، عندما جعلت تجسيد الحلم (ص 15) مرتبطا بولادة ابن ذكر. وكأنّ زوجها لم يُصبح رجلا إلّا بعد أن صار اسمه "أبا وسيم"، كأنّ "أماني" مولودتهم الأولى لم تكن، أو تلاشت فور ولادة الذكر.
والحقيقة التي لا تشوبها شائبة في الحياة وفي الرواية، هو موقف خلود كما يظهر في روايتها. فهي بدافع إنسانيّ نبيل، تُشرك القارئ في خصوصيّات مأساتها، لا لتكسب تعاطفه فقط، ولكن، بوجه خاصّ لتخفّف عنه هول المأساة إذا عاشها، وبوجه عام لتضعه أمام حقيقة أهميّة مشاركته للآخر الذي يحتاج إلى دعمه عند اللزوم، وكم لهذا الدعم من نتائج إيجابية وإنسانية، على من يحتاجه وعلى من يُقدّمه أيضا.
الشكل الفنّي
من حيث الشكل الفنّي، من الصعب اعتبار "أمل في الظلام" رواية، ليس بمعيار عدد كلماتها فقط، ولا بمعيار وقت قراءتها القصير، فإنّ هذين يجعلانها بشكل واضح، قريبة أكثر من القصة القصيرة، وإنّما بوحدة الحدث والموقف أيضا، الذي تتميّز به القصة القصيرة، حيث تعرض الكاتبة حدثا واحدا تتوالد منه كل الأحداث الأخرى، وكذلك موقفا واحدا من قضية واحدة، لا تتغيّر مهما حاولت الكاتبة التنويع بهذا الموقف تبعا للأحداث الفرعية المرتبطة بالحدث المركزي أو القضية المركزية. القضية المركزية هي "مرض التوحّد" وما يترتّب عليه من معاناة يعيشها الإنسان ذو العلاقة المباشرة بمن يُعانيه. وأحد الأهداف الأساسية هو التوثيق الذي يُحوّل الرواية في بعض مراحلها إلى بحث علمي يعتمد على التعريف والفهم والاستنتاج، وإن كان بحثا تطغى عليه الذاتية والعواطف الإنسانية في معظم مراحله. فالكاتبة أحيانا، تُحدّد الزمن الفعلي للألم (أمل، ص 31-33)، وأحيانا تُعرّف "مرض التوحد" كمصطلح علمي حيث تقول: " التوحّد مرض منتشر بكثرة، وغير معترف به من كثيرين، وغير معروف لدى الكثيرين أيضا. هو مرض تصحبه أعراض كثيرة مثل الحركة الزائدة، حب الجلوس بعيدا عن الناس، الانزعاج من الصوت العالي والقدرة القليلة على فهم أبسط أمور الحياة، وعدم استيعاب اللغة، حتى لغة الأمّ" (أمل، ص 32). وأحيانا أخرى تفهم وتستنتج، "علمت الآن لماذا لا يتكلم وسيم، هو لا يفهم اللغة ولا يستوعب ما أقوله" (م. ن.). أو في مكان آخر، "أدركت كم هي الهوّة بين طريقتي وعملهم الفنّي" (أمل، ص 36)، أو "أمّا أسلوب عملهم الفنّي الذي أخذت أتعقّبه دون حراك، فكان نابعا من معرفتهم العميقة ... حيث كانوا على إدراك تام لخطوات الشفاء، بالمنطق العلمي" (م. ن.).
ولكنّها الرواية، ذلك الجنس الأدبي غير المنتهي، المنفتح على الآفاق، وعلى كافة الأجناس الأدبية الأخرى، وغير الأدبية كذلك، وعلى طرق البحث العلمي وغيره، فهي تتسع للجميع، هذا إلى جانب كون الرواية أصلا، بحثا عن الخير والقيم الإنسانية في العالم المنحطّ الذي نعيشه، وفي مستنقعات الحياة، وبحثا عن الخير والقيم الإنسانية قلّما يصدر عن همّ شخصي ليخدم الهمّ الشخصي ذاته، وإنّما ليخدم الهمّ العام والبشرية بأسرها.
وقبل ولوج النصّ من الناحية الفنية، جدير بالذكر أن الكاتبة دعمت نصّها بعتبات ميتاقصّية كثيرة، أعتقد أنّ الرواية على قصرها ومحدوديّة تطورها الفنّي، لا تحتمل هذا الكم الهائل من تلك العتبات. الرواية نفسها لها عنوانان: "أمل في الظلام" و"حكاية أم مع طفل التوحّد؟ هل كانت هناك حاجة لهذا العنوان الثاني المفسِّر؟ على الأقلّ، قصر الرواية ووضوحها ينفي ذلك! فنيّا، كان الأجدر بالكاتبة ترك المهمّة للقارئ، ولكنّ الهدف التوثيقي فرض نفسه على الكاتبة حتى في العنوان. بعد العنوان هناك إهداء يُفشي الكثير من أسرار الرواية. وبعد الإهداء هناك مقدمة للناشر اللبناني، "مؤسسة الرحاب الحديثة"، يبرز فيها قبل قراءة الرواية، تعاطفه مع الكاتبة كونها من عرب الداخل، وذلك وحده دافع كافٍ عنده لنشر الرواية للمحافظة على التواصل، وبعد القراءة، تعاطفه مع تلك الأمّ العربية الصابرة، القوية فكريا وروحيا قبل قوة الجسد كما يقول. وكل ذلك جميل، ولكنّي كنت أفضل لو أنّ تعاطفه مع الكاتبة خالطه شيء من الاهتمام بلغة الرواية وتصحيح بعض ما ورد فيها من أخطاء لغوية، لكان ذلك أجدى للرواية وكاتبتها.
بعد المقدمة هناك نصوص ممهّدة كثيرة، أولها قبل ولوج النصّ يتبعه مفتتح أو تمهيد غير معنون لولوج السرد. والنصوص الأخرى تفتتح كل فصل من فصول الرواية الكثيرة. كل ذلك أثار لديّ السؤال: هل تحتمل رواية بحجم قصة قصيرة كل هذا التقسيم إلى فصول وهذا الكم من النصوص الممهّدة؟ كان من الأجدى للرواية وكاتبتها لو أدرجت تلك النصوص في سياقات فصولها، لدعمت بذلك شعرية اللغة وفنيّة الرواية كلها.
السرد والسارد
ورغم ما تقدّم فأنّ الكاتبة حاولت أن تتوخّي بعض الفنية في سردها للأحداث. فقد اتخذت من مرض التوحّد ومعاناتها الشخصية حاملا للسرد. ولتضمن إقناع القارئ بصدق التجربة، اختارت للسرد صوتها المنفرد، بضمير الأنا، وبدون ذكر اسمها، ما يُحيل إلى الشيء ونقيضه: خصوصية المعاناة وعموميّتها معا، خصوصيّتها لأنّها تجربة الكاتبة أو بطلة روايتها، وعموميّتها، لأنّ الكاتبة تتوخّى منها الفائدة لمثيلاتها من بنات جنسها. وبالنظر إلى خصوصيّتها، يصبح ضربا من البديهة أنّ الراوي هو نفسه الكاتب، وأنّ الأنا المتكلّمة في الرواية هي ذاتها خلود خوري رزق. ولم نلحظ خلال مراحل السرد استعمال أيّ تقنية تنفي ذلك أو توهمنا بأنّ خلود تميل إلى نفي ذلك. وبشكل واضح أيضا، تُطلعنا على أنّها تنطلق في السرد من ذاكرتها الشخصية بعد أربعة عشر عاما من المعاناة، هي عمر ابنها وسيم كما سبق لي أن ذكرت.
وقد حاولت الكاتبة توظيف تيار الوعي الذي تحتاجه الرواية خاصة في التعبير عن معاناة البطلة التي كانت موازية لتطوّر مرض ابنها. ولكنّها إذا أحرزت بعض النجاح في توظيف تقنية الاسترجاع، فقد كان نجاحها أقلّ بكثير في توظيف الحوار الداخلي، المونولوج، الذي كانت تحتاجه للبوح والتعبير عمّا يعتمل في أعماق نفسها من حزن وألم فجّرته مأساة الطفل وتوهّج عاطفة الأمومة.
الشخصيات
تظهر في الرواية مجموعة كبيرة من الشخصيات تتفاوت أدوارها في خدمة الشخصية المركزية، بطلة الرواية التي لم تصرّح الكاتبة باسمها رغم كونها بؤرة السرد. وقد سبق لي أن ذكرت سبب عدم التصريح باسم البطلة. وباستثناء البطلة والطفل، الشخصيات الأخرى التي تظهر وتختفي، هي شخصيات ثانوية جاهزة قلّما تنجح في إدهاش القارئ. وهي تظهر من حيث الشكل تِباعا، تبعا لحاجة الكاتبة في تعميق معاناة البطلة أو التخفيف من حدّتها. ومن حيث المضمون لتدعم فكرة من أفكارها التي تجسّد موقفها الداعم أو المعارض للمواقف الإنسانية المختلفة التي تصطدم بها البطلة في مسيرتها.
البطلة، كامرأة شابة عاشت التجربة التي تنقلها الرواية، هي الشخصية الوحيدة التي تنجح بإدهاش القارئ بما تمرّ به من تحوّل وتتميّز به من إنكار للذات، وموقف إنساني مؤثّر ومبهر. يظهر ذلك في صبرها وقوتها وإصرارها على مواجهة واقعها الجديد، لا لتخفّف من معاناتها ومعاناة وليدها فقط، وإنّما لتخفّف من معاناة المجتمع عامة، ومعاناة كل من يمرّ بتجربة مماثلة لتجربتها.
اللغة
لغة الرواية كانت مباشرة غالبا، بعيدة عن الإيحاء، ولكنّها تفي بحاجات الرواية كرواية وثيقة رغم ما فيها من أخطاء لغوية كان من الممكن تفاديها. وللأسف، اللغة الإيحائية الشاعرية الجميلة، وظفتها الكاتبة خارج النص، في عتباته، تلك التي تسبق النصّ وتلك التي تتصدّر كل فصل من فصوله. تلك العتبات، أو النصوص الممهّدة، حبّذا لو ضمّتها الكاتبة إلى النص وأدرجتها في جسمه وفي سياقات ملائمة، لأعطت بذلك للنصّ ولغته دفعة فنيّة وجمالية كبيرة إلى الأمام، إذ مهما كانت عتبات النص جميلة وإيحائية، تظلّ خارج النص ولا تُشكّل جزءا منه، ولا تُؤثّر كثيرا على تماسك حبكته أو ضعفها، ولا يزيد دورها عن اختزال النص في إشارة سريعة إلى ما ينتظر القارئ فيه، أو تمهيدا يساعد على فهمه.
الإشارات التي توحي بواقعية الرواية، في اللغة وغيرها، كثيرة ولا حصر لها. ولكن، لفت نظري في الرواية ولغتها بشكل خاص، اسمان مأخوذان من اللغة العبرية، هما: "مفراتس" ومركز "ملمان". الأخير هو مركز لعلاج مرضى التوحّد، ولا أعتقد أنّ الكاتبة وظّفته لغير الإيحاء بواقعية الرواية. ولكنّ الأول، "مفراتس"، تلك المنطقة الصناعية في حيفا، التي لا يحظى فيها العمال العرب إلّا بالعمل الشاقّ الأسود، ذكرته الكاتبة لتعكس قسوة الواقع، والمرارة التي شعرت بها عند سماع ذلك الاسم يَرِد بشكل ساخر على لسان أحد الأطباء المتحذلقين الذين تُصوّرهم الكاتبة عبئا على المرضى وعلى المهنة، وذلك حين أنهى الطبيب تشخيصه للمرض بقوله عن "وسيم"، ابن البطلة: "مش ضروري يطلع دكتور متلي، بكفّي ينزل عَ "مفراتس" (منطقة صناعية) للعمل وهذا يكفي" (أمل، ص 24).
اتجهت لغة الرواية غالبا نحو السرد، وقلّما لجأت الكاتبة إلى الحوار، ما يدلّ على اغترابها عن واقعها وصعوبة تواصلها معه. والحوار القليل الذي اعتمدته الكاتبة، قد أجرته على ألسنة شخصياتها غالبا بلغة فصحى بسيطة مطعّمة أحيانا بعبارات عامية أو عامية مفصّحة لم تخلُ من التقعّر والتّرهل. ولكنّها أحسنت حين أجرت العبارة المذكورة أعلاه على لسان ذلك الطبيب المتحذلق، العالة على المهنة، أجرتها بلغة عامية لتسخر منه ولسان حالها يقول له: "أنت والله عبء على مهنة الطبّ، وكثير عليك العمل الأسود في تلك المنطقة السوداء.
* * * * *
وأخيرا، "أمل في الظلام" رواية حقّقت هدفها من الناحية التوثيقية، فقد استطاعت أن تُعرّف القارئ بمرض التوحّد المجهول للكثيرين. وقد نجحت في جعل القارئ يتعاطف ويندمج بالمعاناة التي عاشتها تلك الأمّ التي زعزع كيانها ذلك المرض، مرض وليدها، وقد كاد يُدمّرها ويُدمّر حياة أسرتها، لولا إيمان تلك الأمّ بدورها كأمّ، ذلك الدور الذي جعلها تُنكر ذاتها فخلق صبرها ودعم صمودها في المواجهة. ولكنّ ذلك لا يعني أنّ الكاتبة أخطأت أهدافها الفنية كليّا، فقد أصابت بعضها بشكل مرضٍ أحيانا، وبشكل متواضع أحيانا اخرى. ولكن قليلا من التأنّي والاهتمام بالناحية الفنيّة كان من الممكن أن يقفز بالرواية قفزة نوعية لافتة.
وختاما، إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ كتابة رواية، هي ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض، وأنّ هذه الرواية هي التجربة الروائية الأولى للكاتبة، يُمكننا أن نرى في خلود خوري رزق، كاتبة واعدة، قد تستفيد من تجربتها هذه وتعمل مستقبلا على تطوير قدراتها وآليّاتها.
(كابول: 7/9/2015)