سلام ما بعده سلام، سقوط الامبراطورية العثمانية وولادة الشرق الأوسط الحديث
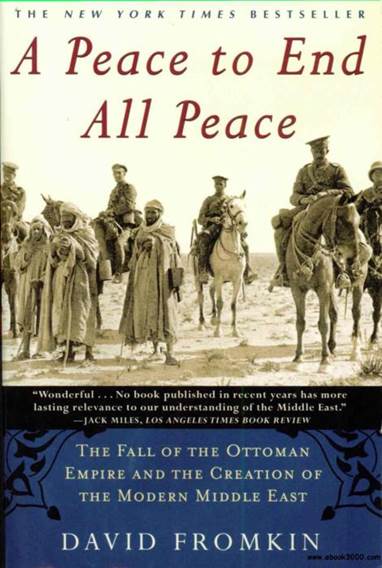
خاتمة طبعة سنة 2009
تأليف: ديفيد فرومكين
ترجمة: فيصل كريم الظفيري
كما يعلم قراء هذا الكتاب، فإن ولادة الشرق الأوسط الحديث حدثت أثناء تداعيات الحرب العالمية الأولى (1914-1918). وقد بدا المشهد السياسي لمنطقة الشرق الأوسط الناطق باللغة العربية، قبل الحرب، مختلفا أشد الاختلاف عما هو عليه اليوم. فإسرائيل والأردن وسورية ولبنان والعراق وتركيا والسعودية لم تظهر على وجه الوجود. فكل هذه البلدان كانت ضمن الإمبراطورية العثمانية الناطقة باللغة التركية؛ وبقي حالها هكذا لمئات السنين- إلى أن خسرها العثمانيون.
إن الذي عمل على ولادة الشرق الأوسط الجديد، وكيفية حدوث ذلك وأسبابه، هو كنه القصة الذي يتحدث عنها كتاب سلام ما بعده سلام، وهو عمل تاريخي سردي نُشر في صيف سنة 1989 واستمرت طباعته منذ ذلك الحين. وتناول الباحثون الكتاب بالتحليل المسهب إسهابا لامعا وتلقى كذلك ثناء عظيما. فما الذي بمقدورنا إضافته على ما سبق، بعد مرور عشرين عاما على نشره، إن كان ثمة ما يضاف؟
أُحيطَ القراء علما بعد الاطلاع على الكتاب، أن إنجلترا وفرنسا اختارتا تدمير الامبراطورية العثمانية، خلال انتصارهما في الحرب العالمية الأولى، بدلا من تثبيتها. أصبح الأوروبيون الغربيون بعد الحرب محتلين ومسؤولين عن حكم المنطقة، فحكم المسيحيون المسلمين. وهو وضع جعل الجانبين غير سعيدين بالمرّة، وألقى كلّ منهما اللائمة على الآخر.
وجدت الجيوش البريطانية والفرنسية الغازية في حرب 1914 السياسة التي تتبناها شعوب الشرق الأوسط مرتكزة على الدين، كما هو أسلوب حياتهم. وقد حاول الأوروبيون جلب سياساتهم معهم -علمانيتهم وقوميتهم ونظم تحالفاتهم- ووجدوا أنها غير قابلة للغرس بسهولة في تربة أجنبية. وما لاقى الاعتراض الشديد، من وجهة النظر شرق الأوسطية، أن أهل المنطقة وجدوا أنفسهم محكومين من غرباء. وحكمُ الأجنبي ممقوت بمرارة في كل أنحاء العالم -وهو مكروه من المسلمين أكثر من غيرهم.
لم تخض إنجلترا وفرنسا الحرب بالمقام الأول كي تغير في منطقة الشرق الأوسط وخارطته السياسية، غير أن المآلات انتهت بهما إلى فعل ذلك. وأدت مجمل الاجراءات التي نفذها الحلفاء الأوروبيون، كالاتفاقيات المبرمة والقرارات المتخذة، إلى صياغة نوع من أنواع تسوية سلام شامل في الشرق الأوسط مع بدايات العشرينيات من القرن العشرين. وترتب وضع كثير من عناصر التسوية في سنة 1922 والفترة المحيطة بها. ولذلك، يطلق اصطلاحا على هذه السلسلة من التغييرات في الكتاب مصطلح “تسوية 1922.”
لقد شابت التسوية أخطاء جمة -على الأقل عندما نتأملها في زمننا الراهن. فقد صُنعت دول ورُسمت حدود تلبية لمصالح بريطانية وفرنسية بدلا من أن تعنى بما تريده شعوب المنطقة وتهتم به. وغالبا ما اتخذ القرارات مسؤولون ووزراء حكومات معرفتهم قليلة عن المنطقة واحتياجاتها. والجدل بأن متخذي القرارات آنذاك، بحكم أنهم أجانب ومن غير المؤهلين للتدخل في حياة الناس الذين عاشوا هناك، هو جدل مقبول وله وجاهة لا بأس بها.
بيد أن خطأ قاتلا أكثر فداحة عاب التسوية: ففي بريطانيا، انقلب الرأي السياسي والرسمي ضد تسوية 1922، وذلك لأسباب سيعلمها قراء هذا الكتاب، وهو ما حدث لحظة إقرارها تقريبا. وعندما يعهد لمسؤولين بتنفيذ سياسة لا يؤمنون بها، فإنها ستنفذ بأسوأ طريقة- أو لن تنفذ البتة. وكل هذا مألوف لدى قراء الكتاب.
لقد كان الشرق الأوسط، قبل الحرب العالمية الأولى، منطقة راكدة لا حراك ذي بال فيها. غير أنها أصبحت منطقة مضطربة بعد ما حلت الولايات المتحدة محل بريطانيا بموقعها المهيمن على المنطقة بين منتصف الأربعينيات ومنتصف الخمسينيات من القرن العشرين. عندما ظهر إلى النور كتاب سلام ما بعده سلام قبل عشرين عاما، لوّحت حرب الخليج، التي بدأت سنة 1991، بظهور حقبة أكثر اضطرابا عن السابق في المنطقة، وهو ما طفح كيله ليصل إلى بقية العالم وبلغ الذروة في الخطب الجلل في “أحداث الحادي عشرل من سبتمبر.” فهل وقع ذلك بسبب وجود خطأ ما بتسوية سنة 1922؟ أو أن ثمة خطأ بالشعوب التي صيغت من أجلها تلك التسوية؟ ولماذا كانت مجدية لبعض بلدان الشرق الأوسط وغير مجدية لبعضها الآخر؟ ثمة مشاكل ومسائل كانت خارج نطاق موضوع الكتاب، لكنها تحظى بأهمية بالغة في الوقت الراهن.
إن مشكلة عدم تجانس بعض مناطق الشرق الأوسط، في حين أنها منسجمة في مناطق أخرى، تعود إلى الشرعية. فبعض البلدان حققت الشرعية، لكن بلدانا أخرى لم تحققها. وثمة بلدان متجاورة وافقت على خطوط حدودها، وأخرى لم توافق. وهناك بلدان قبلت جيرانها كدول مستقلة، وأخرى لم تقبل.
وتفضي الحيازة المستمرة إلى منح ألقاب جميلة؛ ولهذا تظل أرض مصر الأزلية وبلاد فارس الامبراطورية، وهما البقعتان الناجيتان من العالم القديم، لا ينازَعان بمزاعمهما بامتلاك كيان للدولة. أما الدول الجديدة التي صنعها رجال أقوياء تنحو لأن تكون مقبولة أيضا، طالما أن الرجال أقوياء فعلا ومن أهل البلاد أصلا: وللمرء أن يفكر بمصطفى كمال أتاتورك وجمهوريته التركية وعبد العزيز بن سعود ومملكته السعودية. وثمة صنف ثالث لا يبدو أنه يجيد قبول التسوية، مثل نماذج: العراق وسورية ولبنان والأردن وإسرائيل. وهؤلاء هم ابناء إنجلترا وفرنسا، وولدوا من رحم اتفاقية سايكس-بيكو-سازانوف وتعديلاتها؛ وقد أشير مرارا إلى أن قلب المشكلة يكمن في ما أنشأوه من اتفاقية. غير أن الأمثلة المستنبطة من مناطق أخرى تشير إلى أنه ما دام الأمر هكذا، فإنه ليس هكذا بالضرورة.
إن مسألة إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط لم تكن الأولى من نوعها في التاريخ الحديث. فقد خلفت الإمبريالية الأوروبية وراءها قضايا نزاع مماثلة في أراضٍ أخرٍ بعيدة. فأمريكا اللاتينية هي أول المناطق التي تحررت من الاستعمار في العصور الحديثة بدءا من هاييتي والمستعمرات الأسبانية في بدايات القرن الثامن عشر. وعلى مدار الأربعمائة عاما المنصرمة، أي منذ وصول كرستوفر كولمبوس سنة 1492، فرض الأوروبيون حدودهم الخاصة بهم على خارطة الأراضي الجديدة في أمريكا الجنوبية، وغالبا ما حدث ذلك لأسباب تتعلق بملاءمات إدارية محضة؛ ولو أن الشعوب الأصلية حملت السلاح لتأسيس دول وحدود بناء على تطلعاتهم القومية وتموجات واقعهم السياسي -كما فعلت الأمم الأوروبية بدءا من الثورة الفرنسية سنة 1789- لأصبحت حمامات الدم مستمرة بلا توقف في أرجاء أمريكا الجنوبية. ولغدا ذلك حمام دم بلقاني يجر إلى مئات المستنقعات الشبيهة بسراييفو.
إلا إن بلدان أمريكا اللاتينية التزمت بدلا من ذلك بمبدأ اختياري في القانون الدولي العام والمعروف “بمبدأ قدسية الحدود”. ويقبل هذا القانون، المستمد من الشرائع الرومانية القديمة، التركيبة السياسية للمنطقة وقت التحرر من الاستعمار، ويجسد حكمة غابرة مفادها: لقد أمر الرب زوجة لوط ألا تنظر إلى الوراء. فقد أدركت أمريكا اللاتينية أن السعي وراء الماضي قد يؤدي إلى المجازفة بالحاضر والمستقبل معا.
ومن جهة أخرى، عندما مرت أفريقيا بدورها بتجربة التحرر من الاستعمار منذ ستينيات القرن العشرين، توجهت لتطبيق ذات المبدأ أيضا. ويغلب على المشهد السياسي الأفريقي الطابع القبلي، لكن إذا ما أقدمت كل قبيلة على خوض قتال لنيل الزعامة والتفوق ضمن حدود أسلافها فإن هذا سيعني كارثة، وقد وقعت كوارث فعلا في بعض المناسبات. لقد آثرت أفريقيا، في أول مؤتمر للدول الأفريقية خاص بإقامة منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1963، الالتزام “بمبدأ قدسية الحدود”. وقد أكدت قرارات محكمة العدل الدولية على القواعد القانونية الخاصة بسريان وضع ما بعد الاستعمار. وبذلك تستمر قارتا أفريقيا وأمريكا الجنوبية بالتعايش بناء عليها.
كما ذكرنا سابقا، يغلب الطابع القبلي على المشهد السياسي في أفريقيا. أما في الشرق الأوسط فإن السائد هو الطابع الديني. وتستنزف القبيلة والدين طموحات ودوافع قوية، وفي إطار البحث عن السلام ومن ثم التوصل إلى التوافق والتسوية المقبولة، فهما يعدان معوّقين قويين، ويتحتم التغلب عليهما. ولا بد من تطبيق “مبدأ قدسية الحدود” -في مرحلة ما- إذا ما أريد للشرق الأوسط أن يحقق السلام والاستقرار. ويبقى السؤال ماثلا أمامنا: في أية مرحلة يحدث ذلك؟ أما الجواب العملي الوحيد فهو: الآن.
لقد أحدث الهجوم على الولايات المتحدة يوم الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة امتحانا صادما للعالم الغربي. فقد جلب حمامات الدم الجارية في الشرق الأوسط إلى الأراضي الأمريكية، وفي داخل غرف نومنا. وما أثار الحيرة والارتباك لدى كثير من الناس أن أسامة بن لادن، زعيم الإرهابيين، لجأ إلى تبرير الهجوم على أنه رد على ما ارتكبه الغرب قبل ثمانين عاما. والأمريكيون على وجه الخصوص لا يعلمون عن التاريخ سوى النزر اليسير؛ وقد بحث معلقو الأخبار على الشاشات التلفازية عن تفسيرات لذلك. فتساءلوا مندهشين، ما هو الأذى الذي ارتكبته أمريكا أو حلفاؤها في حق قوم بن لادن في بداية العشرينيات؟ أما الجواب بالطبع فتمثل في قيام الجيوش المسيحية باحتلال أراضي الامبراطورية العثمانية الإسلامية، فبدّلت قوانينهم وحكوماتهم، وأقامت بدلا منها دولا وحدودا على النمط الأوروبي. وقد عزمت الكيانات الجديدة على تحقيق الأهداف والمصالح القومية الغربية وتجسيدها على أرض الواقع دون أن تسعى لإنجاز رفاهية وخير الشرق الأوسط الإسلامي. وزبدة القول، يستنكر بن لادن تسوية 1922، ويلقي اللائمة على أمريكا بذلك، على الرغم من أنها لم تكن طرفا فيها. ولعل ما يثير الاستغراب أنها حجّة رجعية كما أنها أحادية الجانب؛ ذلك أن المسلمين والمسيحيين أقدما معا في الماضي على شن حروب دينية. من الجائز النظر للصليبين على أنهم بائسين مثيرين للشفقة، وربما توجب على أوروبا رفضهم واستنكارهم بشدة، لكن بإمكان الغربيين بسهولة أن يشتكوا لابن لادن من الدمار الذي حاق بأوروبا على أيدي قبائل الهان والمغول والترك والقبائل المحاربة الأخرى التي خرجت من آسيا وزحفت غربا في عصور قديمة من التاريخ.
لقد نبّه الهجوم على برجي نيويورك التوأمين الرأي العام الأمريكي والأوروبي إلى الخطورة الشديدة للنزاعات الدموية في الشرق الأوسط، وإلى عجز هذه المنطقة المتكرر عن الوصول إلى حلول سلمية لصراعاتها الجارية. بيد أن الصراع العربي-الإسرائيلي، على وجه الخصوص، يبدو أنه يزداد سوءا. وهكذا لم يتجسد مبدأ قدسية الحدود، ولم يدنو منه أحد أصلا، أما الشرعية فلم تحققها بلد من بلدان المنطقة.
كان عام 1989 –الذي صدر به كتاب سلام ما بعده سلام- هو العام الذي تحطم فيه جدار برلين، وزوال الخطر السوفييتي الذي هدد العالم كما بدا آنذاك –بما فيه التهديد الواقع على منطقة الشرق الأوسط. وقد احتل موضوع مشابه لتفكيك القوة الروسية ثم ظهورها مجددا، الفصول الختامية لكتاب سلام ما بعده سلام. والحقيقة أن التقلبات في مسألة الخطر الذي يشكّله الروس، حسب المنظور طويل المدى، كان موضوعا متكررا في السياسة العالمية طوال القرنين المنصرمين- من وجهة النظر الغربية على الأقل.
وقد مثّل الوجود السوفييتي في الشؤون العالمية مصدر إحباط لأجيال عديدة من صناع القرار الأمريكيين، بما فيهم أولئك الذين ساهموا بتأسيس منظمة الأمم المتحدة. فقد ابتغى فرانكلين روزفلت ومعاونيه من خلال ترتيب أوضاع السلام بعد الحرب العالمية الثانية القيام بعكس ما فعله الحلفاء في تسوية 1922. حيث عملوا على تبني حق الاستقلال وتقرير المصير، وأولى أولوياتهم في ذلك –أو هكذا تصوروا الأمر- مراعاة رغبات وتطلعات الشعوب التي اتخذوا قرارتهم من أجلها. غير أن الاتحاد السوفييتي الجامد عرقل واشنطن في أماكن الأزمات كلها. فالسوفييت، بغض النظر عن آيديولوجيتهم الشيوعية، كانوا عازمين كل العزم على خدمة مصالح بلادهم فقط، مثلما كان، على سبيل المثال، عزم الفرنسيين إبان مفاوضات تسوية 1922.
ولذلك عندما انفصمت عرى الاتحاد السوفييتي قبل عشرين عاما، كان ذلك بمثابة تحرير للأمريكان. فالآن أصبح بمقدور حكومتنا – كما أشيع على ألسن الناس- فعل أي شيء نريد منها أن تقوم به بحرية. وكررنا بلا كلل الوصف المبهج لوضعنا الجديد: “القوة العظمى الوحيدة.” ولقد قادت الولايات المتحدة، بعد أحداث 1989، حملة دولية مكونة من ائتلاف عسكري في بداية التسعينات لحرب الخليج وذلك لتجسيد حرية أمريكا الجديدة ميدانيا. فأبطلنا الغزو العراقي للكويت وأعلنّا عن بزوغ “نظام عالمي جديد.” وزعمنا أننا لم نعد بحاجة إلى أن نأخذ في الحسبان الرد الذي قد يقوم به السوفييت. وقد يكون ذلك خرابا لنا.
لم نعبأ بأن نذكّر أنفسنا بالحكمة المعتبرة التي تحذّر من أن القوة المفرطة بلا كوابح مظهر خطير: وهو خطير حتى لو كنا نحن من يمارسه، وخطير ليس على الآخرين فقط، بل على أنفسنا أيضا.
يبدو الآن كما لو أن الولايات المتحدة لم تتمتع بالقوة المطلقة قط. لكن لم يشك الأمريكان، لا سيما في وسائل الإعلام والأكاديمية (العسكرية)، أننا كنا كذلك؛ وأن ما اختارت الولايات المتحدة فعله -في العراق وأماكن أخرى- بالحرية غير المقيدة التي تصورت أنها تمتلكها قد يشير إلى أنه من الجيد أننا لم نكن بتلك القوة التي اعتقدنا امتلاكنا لها. وربما يظهر هذا أن حالنا كان سيغدو أفضل بحرية اختيار أقل، وقدرة أقل على ارتكاب الأخطاء.
عند مراجعتنا للخطر الموازي الذي مثلته قوة الاتحاد السوفييتي أثناء حقبة الحرب الباردة مراجعة فعلية، يظهر لنا بجلاء أنها منحتنا نوعا من الانضباط الذي ألزمنا اتخاذ تصورات حذرة ومتأنية حيال الحقائق المختلفة، وجعلتنا نفكر بجد واجتهاد في صياغة السياسات التي ننتهجها؛ وقد تكون كذلك، وإلى حد معين، علاجا ناجعا لنا.
“تذكّر الموت”: يبدأ كتاب سلام ما بعده سلام بتذكرة مفادها أن حتى أعظم الامبراطوريات تفنى. فيستهل الكتاب صفحاته بوصف يخت البحرية البريطانية انشانترس وهي تمخر عباب البحر الأبيض المتوسط في نزهة بحرية. ومن ضمن ركابها رئيس الوزراء –وقائد- الامبراطورية البريطانية. وحكمت بريطانيا في ذلك الحين امبراطورية عظمى في العالم، وهي بالفعل أعظم امبراطورية شهدها العالم.
كان رئيس الوزراء ومن رافقه من السائحين، فقد جاؤوا للاطلاع على بقايا آثار العالم القديم، وتجولوا عبر الأزقة المهشمة للامبراطوريات الغابرة التي انشأها الفاتحون العظماء كالإسكندر الكبير والقياصرة، وجاء بالذكر الأكّاديون الذين انشأوا أولى امبراطوريات الأرض منذ فجر التاريخ.
لقد عاش الضيوف على متن اليخت انشانترس في عالم من الامبراطوريات. فإذا نحينا جانبا امبراطوريتهم، كانت توجد امبراطوريات حلفائهم، كالامبراطوريتين الفرنسية والروسية، وامبراطوريات أعدائهم فيما بعد، كالامبراطوريتين الألمانية والنمساوية. أما الامبراطورية العثمانية فقد حكمت الشرق الأوسط كما كان عليه الحال منذ خمسمائة عام، وقد حكمته كذلك الامبراطورية الفارسية في الماضي، بشكل أو بآخر، لمدة تناهز ألفين وخمسمائة عام.
كل ذلك تبدّل وتحوّل –بل إن العالم كله تبدّل- بعد الحرب العالمية البشعة بين عامي 1914-1918 واتفاقية السلام الكارثية التي تلتها.
عندما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها، فرض الحلفاء، الذين عملوا على السيطرة على مستقبل الشرق الأوسط، مجموعة من الترتيبات السياسية على العالم العربي انتُقِدَت بشدة بوصفها اجراءات امبريالية، لسبب لا يخلو من الوجاهة. وعند تأملنا للدروس التي يقدمها هذا الكتاب، فإننا نحث القارئ على الترفق عند الحكم على أشخاص عاشوا بعصر سابق واتسم ببراءة أكثر، وتجربتهم أقل من تجاربنا –ولكي نضع بعضا من النقاط المخففة لتلك الصورة القاتمة في الأذهان، فإننا نطرح التالي:
أولا: لم يعرف أولئك الذين صاغوا تسوية 1922 سوى أجواء عالم الامبراطوريات التي كانت تحرك جلّ دوافعهم وتفكيرهم. ولذا ليس من الانصاف قذف الانتقادات لهم على ذلك. فكل الأطراف تقريبا كانت تحركهم آنذاك الدوافع الامبريالية. فالمنتصرون كانت لهم امبراطوريات، لكن هذا ينطبق كذلك على المنهزمين.
ثانيا: على الرغم من أن رجالات الدولة في ذلك الحين، وفي إطار جهودهم لإعادة بناء الشرق الأوسط بعد الحرب، سعوا فقط نحو تحقيق مصالح بلدانهم القومية قبل قرن مضى، إلا إن ذلك هو الذي كان يفترض بهم عمله، وهو من صميم وظيفتهم. أما في عالمنا الحديث الذي يرتبط بعضه ببعض فالهموم الخارجية الأوسع مطلوبة بل تحظى بتشجيع وعناية. وفقط في العصر الحالي نزعم أننا نتحدث باسم البشرية ولصالحها.
ثالثا: في ذات الوقت الذي يبدو فيه قول المسؤولين البريطانيين في العشرينيات والثلاثينيات: إن البلدان العربية لم تكن مستعدة لحكم ذاتها ما هو إلا قول شوفيني –بمعنى جاهزيتها لتكوين أنظمة ليبرالية وديمقراطية ودستورية منضبطة بحكم القانون- إلا إن ما ثبت من دليل على أرض الواقع يجعل من قولهم ذاك غير بعيد عن الصحة. ويظهر لنا من سجلات أرشيف مجلة الإيكونوميست (عدد الثالث من أبريل، 2004، صفحة 47) النص التالي: “تظل الدول الإثنين والعشرين الأعضاء في جامعة الدول العربية المنطقة الأكثر نخبوية وخضوعا لحكم الأقلية بانتظام في العالم. فلا يوجد على الإطلاق حاكم عربي واحد خرج من السلطة سلميا عبر صناديق الاقتراع.”
رابعا: إن القواعد الجوية والمراكز العسكرية التي احتفظت بها بريطانيا في الشرق الأوسط استنادا إلى تسوية 1922 مكّنت البريطانيين من صد خطر القوات الموالية للنازية عبر أرجاء الشرق الأوسط –في العراق، وإيران، وفلسطين، ومنطقة سورية ولبنان، ومصر- وذلك عند اندلاع الحرب العالمية الثانية. ومن وجهة النظر البريطانية –وهي وجهة النظر الوحيدة التي يُتوقّع أن يتبناها المسؤولون البريطانيين- فإن ذلك الإجراء قد أثبت صدقية التسوية وأظهر قيمتها الإيجابية.
إن بعض المشاكل الدولية التي نشأت من الأحداث التي سردها كتاب سلام ما بعده سلام تبدو حتى اللحظة غير قابلة للحل. لكن إذا وسعنا الرؤية قدما، كما يفعل المؤرخون أحيانا، فإن وجهات النظر قد تتباين. فالمشاكل على المدى البعيد يمكن لها أن تُحل، بل وفي غالب الأحيان تُلغى وتزول. والعدوات القديمة يمكن لها أحيانا أن تُنسى مع نشوء عداوات جديدة. ومهما يكن من بطء تغيّر الناس على فترات طويلة، إلا إن تغيّرهم واقع في النهاية؛ وعلينا ألا نغفل عن حقيقة أن رخاء أوروبا واستقرارها على خارطتها الجديدة استغرق ألفا ونصف الألف من السنين بعد سقوط الامبراطورية الغربية لروما، كما سبق وأن ذكّرت قرّاء هذا الكتاب.
كان سقوط الامبراطورية العثمانية أحد أهم الاضطرابات في التاريخ. لم يكن ذلك على مستوى سقوط روما، ولم تحظَ حكومات الباب العالي العثمانية بتلك الجذور شديدة العمق التي تمتع بها القياصرة. بيد أن ذلك السقوط مثّل بحد ذاته حدثا ضخما –بل زلزال سياسي- ولم يكن من المتوقع سوى أن تجميع الشظايا المحطمة على صورة أو أخرى لتأخذ شكل الاستقرار والديمومة سيستغرق وقتا من الزمن.
سعت الولايات المتحدة، مع بزوغ فجر الألفية الجديدة والقرن الواحد والعشرين، دفع التاريخ إلى الأمام من خلال غزو العراق. ومن المنتظر تأليف كتب كثيرة لا حصر لها حول هذا الحدث الاستثنائي وتداعياته. ومن زاوية احتفالية الذكرى العشرينية التي نقدمها لكتاب سلام ما بعده سلام، فإن ما يلزم علينا قوله حول الشرق الأوسط آنذاك والآن، هو أن كثيرا من الأحداث قد حصلت، لكن لا يظهر بالرغم من ذلك أن أمرا جوهريا قد تغيّر.
وسوم: العدد 766